عندما نشرتُ قبل حوالي سنتين، أي قبل أن يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بانقلابه، مقالاً عن تاريخ الوشاية في تونس، في رصيف22، كنت أعتقد أن الحكاية أصبحت جزءاً من التاريخ، وأن الحديث عن هذه الظاهرة التي ارتبطت بالدولة البوليسية في عهد الحزب الواحد لن يكون إلا حديثاً في تاريخها. ولكن التاريخ يبدو أشد مكراً مما نعتقد.
اليوم، أعود للكتابة عن هذه الظاهرة وهي تنبعث من رمادها كي تستأنف دورها "الوطني" في حماية البلاد "من العملاء والخونة والمعارضين" كما يسميهم سعيد نفسه.
في 27 شباط/ فبراير الماضي، وبينما كان كل من وسام الصغير وبثينة خليفي وأسامة غلام، بصدد كتابة شعار سياسي احتجاجي على حائط عريض في أحد شوارع تونس العاصمة، محتمين بظلام الليل، مرّ بالقرب منهم سائق سيارة أجرة، ودون تفكير طويل غيّر وجهة مقوده نحو مركز الشرطة ليقدّم وشايته ساخنةً. لم تمضِ سوى دقائق حتى توقفت بالقرب من الشباب الثلاثة سيارة تابعة لجهاز الأمن وحملتهم مخفورين إلى مركز الشرطة ثم رأساً نحو التوقيف بإذن من النيابة العامة.
كانت التهمة "الاعتداء على الأملاك العامة"، أما الشعار السياسي فقد كان يطالب بإطلاق سراح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، المعتقل في قضية التآمر على أمن الدولة. ورغم أن حيطان المدن التونسية تزدحم بالشعارات المؤيدة للرئيس سعيد، إلى أن شعاراً واحداً ضده تحوّل إلى اعتداء على أملاك الشعب، مما يدل على أن التوقيف لم يكن دافعه حماية الأملاك العامة بقدر ما كان عقاباً على جوهر الشعار السياسي المكتوب بخط أحمر عريض وواضح.
قبل ذلك، أطلق الرئيس التونسي حملة اعتقالات واسعة طالت معارضيه من رجال أعمال وسياسيين وصحافيين بتهم التخطيط للإطاحة بنظام حكمه واغتياله. وحدث كل ذلك بناءً على ثلاثة تقارير قدمها وشاة أشير إليهم بحرف ''X". ورغم أن ملف القضية "خالٍ من أي أدلةٍ واضحةٍ على فعل التأمر"، كما كشف عن ذلك محامو المعتقلين بعد اطلاعهم على الملف القضائي، إلا أن القاضي اكتفى بالوشاية بوصفها حجةً بنفسها قادرة على تعليل توقيف هؤلاء. ورغم أن الأمر يتعلق بالأمن الوطني، إلا أن الوشاة الثلاثة رفضوا الكشف عن أسمائهم. فإذا فرضنا تجاوزاً أن هذا الواشي يدافع عن "أمن الوطن"، فلماذا لا يواجه العدالة بوجه مكشوف، أليس في ذلك فخر وطني عظيم؟
لو لم تكن الوشاية خِزياً، لما أُطلق على صاحبها رمز النكرة في الرياضيات البحتة''X" . لماذا يختفي الواشي خلف الرموز؟ ليس خوفاً، لأنه موضوعياً في معسكر الجهة الأقوى وهي السلطة، ولكنه الشعور بالعار. الواشي غالباً ما يكون واعياً بذاته، أي واعياً بخزي صنيعه، لذلك دائماً يكون الخفاء بيئته المفضلة، لأنه حين يكون في الخفاء لا يواجه نفسه في المرآة، ذلك أن المرآة هي الآخر.
في الخفاء يصنع الواشي لنفسه عالماً من التبرير لصنيعه، تحت شعارات حب الوطن والذود عنه، لكن هذه التبريرات ما تلبث أن تنهار في مواجهة الآخر في العلن، لأن الآخر يطرح حجته المضادة لتبريرات الواشي فيُحدث ذلك ارتباكاً في نفسه، لأنه على يقين راسخ بأنه لا يدافع عن الوطن ولكن عن الحاكم، وهنا يكون الشعور بالعار أشدّ.
لكن لماذا تعود الوشاية بقوة في تونس اليوم، رغم أنها تسمى على سبيل التشنيع، في العامية المحكية بـ"القِوادة"، في تشبيه شعبي بين الوشاة والعاملين في الدعارة المأجورة، ورغم وعي الواشي بنفسه بأنه يقوم بفعل مخزٍ؟
تفترض الإجابة على هذا السؤال: أولاً، إدراك تلازم وضع جميع السلطات في يد فرد واحد مع تعاظم قوة أجهزة المراقبة والقمع؛ وثانياً، تلازم صعود الشعبوية بوصفها نظام حكم مع ترسيخ انقسام اجتماعي بين معسكر الخير ومعسكر الشرّ، أي مناخ الحرب بكل ما تعنيه رمزياً من وجود وطنيين وخونة.
إعادة إنتاج الدولة البوليسية
لم يكن انقلاب قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو لينجح، لولا الدعم الذي تلقاه من المؤسسة العسكرية والأمنية. لعب ولاء هذه الأجهزة للرئيس دوراً حاسماً في سيطرته على جهاز الدولة وعلى الفضاء العام خلال ساعات، وكذلك في تحييد جميع خصومه السياسيين. كان هذا الانقلاب محروساً منذ بدايته بأجهزة القمع الرسمية، لكنه كان أيضاً يحظى بولاء قطاعات واسعة من النخبة السياسية والنقابية ومن الطبقة الوسطى.
مع مرور الوقت، بدأت روابط الولاء بين الرئيس التونسي سعيد والنخب تتآكل حتى وصلت إلى مرحلة من المعارضة المعلنة، أبرزها معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان الداعم الأبرز لسعيّد بدايةً، وصولاً إلى استحقاق الاستفتاء على الدستور، الذي كان خيبة أمل شعبية بالنسبة إلى الرئيس التونسي، إذ لم يشارك فيه سوى 30% من الجسم الانتخابي.
في ورقة نشرها عام 2012 تحت عنوان: "الركائز الثلاث للاستقرار: الشرعية والقمع والاستقطاب في الأنظمة"، يضع الباحث الألماني يوهانس غيرشوسكي إطاراً نظرياً للآليات التي يسلكها أي نظام، ذي نزعة استبدادية، لترسيخ سيطرته على الدولة والمجتمع.
يرى غيرشوسكي أن القوة، بوصفها استخدام العنف الجسدي لمنع سلوك سياسي معيّن أو أنشطة معينة، لا تكفي وحدها لبناء حالة استقرار للنظام، بل تحتاج إلى الشرعية، باعتبارها العملية التي تسعى الدولة من خلالها إلى حيازة رضى المحكومين، وكذلك الاستيعاب بما هو قدرة النظام على ربط مجموعات مهمة استراتيجياً، مثال النقابات وأصحاب الأعمال والمنظمات غير الحكومية بالسلطة الحاكمة.
في ظل فقر الشرعية، يسعى الرئيس التونسي إلى المحافظة على ولاء الأجهزة الأمنية له، من خلال نهج تبادلي: يوسّع من نفوذها ويطلق يدها للعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل ثورة 2011، والأهم من كل ذلك يمنحها حصانة
في هذه الثلاثية لإنتاج الولاء، لا يملك سعيد اليوم سوى القمع، فقد فَقَدَ شرعيته الانتخابية، أولاً من خلال الانقلاب، ثم من خلال النتائج الهزيلة لنسب المشاركة في الاستفتاء على الدستور وتالياً في الانتخابات التشريعية مطلع العام الحالي، إلى جانب غياب "شرعية الإنجاز الاقتصادي"، إذ تعيش البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. كما عجز في الوقت نفسه عن استقطاب أصحاب المصالح الممثلين للفئات، كالنقابات والاتحادات المهنية وغيرها من القوى التي تملك قاعدة اجتماعية. لذلك لم يبقَ في يده سوى ورقة الجيش والشرطة والقضاء، كي يُحكم سيطرته على السلطة.
في ظل فقر الشرعية هذا، يسعى الرئيس التونسي إلى المحافظة على ولاء الأجهزة الأمنية له، من خلال نهج تبادلي: يوسّع من نفوذها ويطلق يدها للعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل ثورة 2011، والأهم من كل ذلك يمنحها حصانة، وهذا ما يعطي الجهاز الأمني اليوم قوةً توشك أن تضاهي قوة السلطة السياسية.
لكن وجود ثقل المحافظة على النظام فوق رأس الجهاز الأمني، بوصفه المسؤول عن السيطرة على الفضاء العام الداخلي، سيجعله بالضرورة يتوسع، وأحد أشكال هذا التوسع هو توسيع شبكة المخبرين، والتشجيع على الوشاية الطوعية. ويبدو أن هذه الوسائل قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال تواتر الاعتقالات القائمة على الوشاية. وبالتالي، نجد أنفسنا اليوم أمام إعادة إنتاج للدولة البوليسية التي أدارت البلاد لعقود، لكن ضمن شروط جديدة تتعلق بطبيعة الحكم الشعبوي نفسه.
يعرّف عالم السياسة الفرنسي برنارد لاميزيت الدولة البوليسية بأنها دولة تخضع لقانون الشرطة، وهي دولة تُظهر فيها الشرطة شكلاً من أشكال الاستقلال الذاتي في مواجهة السلطات السياسية، إذ تسعى الشرطة دائماً إلى زيادة قوتها، على المدى الجغرافي للدولة، وداخل أغلب مناحي نشاطات المجتمع، ذلك لأن السعي الدائم إلى التوسع هو جزء من منطق القوة الذي يحكمها.
لكن لاميزيت يضيف خاصيتين أخريين إلى هذه الدولة البوليسية. الخاصية الأولى هي الصمت الذي تتسم به نشاطات جهاز الشرطة في هذه الدولة، فهي حالة لا تُلفظ فيها الكلمات، وهذا ما نراه يحدث اليوم في ملف الاعتقالات، إذ تهاجم الشرطة منازل المستهدفين وتعتقلهم دون تقديم أي توضيحات أو أذون قانونية من القضاء، ثم تقود المعتقل إلى جهة غير معلومة، دون إخطار عائلته أو محاميه بمكانه، كما ينص على ذلك القانون، ليظهر لاحقاً أمام النيابة العامة بعد أن تكون العائلة قد جابت جميع مراكز الشرطة والتوقيف والمستشفيات بحثاً عنه.
يُعيد نظام الرئيس التونسي إنتاج الدولة البوليسية وفقاً لرؤية شعبوية للسلطة تقسّم المجتمع إلى معسكر الخير المطلق، ويقوده الرئيس ويتكون من الشعب الحقيقي، في مواجهة معسكر الشرّ المطلق الذي يضم النخب السياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والنقابية
أما الخاصية الثانية فهي القوة المرئية وغير المرئية للشرطة في المدى المكاني. تتحول عسكرة الشوارع بالظهور المفرط لرجال الشرطة إلى نوع من فرض منطق القوة، كما تظهر هذه القوة في أشكال غير مرئية مثل نشر شبكات الوشاة والمخبرين داخل مفاصل المجتمع. وهنا تنقسم فئة المخبرين إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى وههم المخبرون العَرَضيون، كالشهود على حدث معين، والمتطوعون؛ والطبقة الثانية المخبرون المنتظمون، وهم مَن يقومون بتزويد الشرطة بالمعلومات بشكل متواتر، ويشغلون عادةً مهناً ووظائف يختلطون فيها بالناس على نطاق واسع، مثل سائقي سيارة الأجرة وموظفي الفنادق والمثقفين وغيرهم؛ والطبقة الثالثة، المخبرون المحترفون وهم الذين تدفع لهم الأجهزة الأمنية مكافأة في شكل نقدي أو في شكل خدمات مثل التوسط لهم في الحصول على رخص للعمل في قطاعات معيّنة تحتاجهم فيها أو لفتح مقهى أو حانة أو الحصول على رخصة لسيارة تاكسي...
الأغلبية دائماً على صواب
يُعيد نظام الرئيس التونسي قيس سعيد إنتاج الدولة البوليسية وفقاً لرؤية شعبوية للسلطة تقسّم المجتمع إلى معسكر الخير المطلق، ويقوده الرئيس ويتكون من الشعب الحقيقي، في مواجهة معسكر الشرّ المطلق الذي يضم النخب السياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية والنقابية، وكل الأجسام التي يمكن أن تشكل وسيطاً بين الشعب والسلطة السياسية. هذه الرؤية التبسيطية والمختزلة للصراع السياسي في المجتمع هي رؤية حربية، تقسم المجتمع بين وطنيين صادقين، كما يسميهم الرئيس سعيد، وعملاء وخونة كما يصفهم دائماً.
وهذا ما دفع وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إلى القول في اجتماع عام: "رجال إعلام مرتزقة ورجال أعمال باعوا الوطن ونقابيين باعوا الوطن وأحزاب باعت الوطن. النخبة السياسية هي نكبة سياسية. تحالفوا جميعاً ضد الشعب التونسي... إنهم خونة"، مضيفاً: "التفوا حول رئيس الجمهورية لأنها حرب ضروس... حرب ضروس حرب ضروس".
هذا المناخ الحربي يحاول أن يصوّر أفعال الجهاز الأمني على أنها أخلاقية، ومن بينها الوشاية. ذلك أن الحرب، بوصفها التناقض الأقصى الذي يمكن أن يعيشه أي مجتمع، تشكل رمزياً حالةً من الاصطفاف، وتتحول فيها بعض الأفعال المنبوذة في أوقات السلم إلى بطولات.
تصوير الصراع السياسي على أنه حرب بين وطنيين يقودهم قائد وطني في مواجهة حفنة من الخونة والعملاء يعطي شرعيةً أخلاقية لأي سلوك مرفوض قانوناً وأخلاقاً، يمكن أن ترتكبه الأجهزة الأمنية في حق هؤلاء المعارضين للسلطة، كما يعطي المبررات الأخلاقية للمخبرين والوشاة كي يتطوعوا ويتوجهوا من تلقاء أنفسهم إلى مراكز الشرطة للإدلاء بمعلومات تورط هؤلاء "العملاء"، دون النظر في جوهر هذه المعلومات، إنْ كانت صحيحة أو مفتعلةً أو كيديةً. ذلك أن العقل الشعبوي لا يقيم وزناً كبيراً لذلك، فالمعارض مدان سلفاً والأغلبية دائماً على حق، في تعارض تام مع وصية جون بول سارتر حول أنه "لا يجوز الخلط بين الحقيقة ورأي الأغلبية".
عندما تصبح الشعبوية نظاماً للحكومة، أي عندما تفوز بالأغلبية، فإنها تميل إلى تفسير الحريات والحقوق والمؤسسات كأدوات لمَن هم في السلطة. يمكنك القول إنه حتى أولئك الذين ليسوا شعبويين، عندما يصلون إلى السلطة، يتصرفون بنفس الطريقة. ومع ذلك، إذا حاولنا في هذه الحالة على الأقل الاعتراف بعمومية القواعد وحيادية مفهوم المساواة الخاص بسيادة القانون، فإن الشعبوية في السلطة لا تتردد في القول إنه من المشروع استخدام المؤسسات لصالح أولئك الذين يحكمون، على وجه التحديد لأنهم يمثلون الأغلبية.
فالشعبوي في السلطة لم يعد لديه حتى الإرادة لإخفاء مقاومته للوساطة السياسية، ورغبته الدفينة في كسر أي تعدد. على العكس من ذلك، يؤكد صراحة أن السياسة فوق كل شيء، قوة مَن هم في السلطة. لذلك، في الديمقراطية التي تمارس السلطة كحكم الأغلبية، تكون الشعبوية أكثر شرعية لأنها، ولكونها تعبيراً عن الأغلبية، يمكنها استخدام تلك القوة لنفسها. هذا الجانب الأساسي المناهض للمعايير، ليس فقط من وجهة نظر أخلاقية ولكن أيضاً من وجهة نظر قانونية، هو ما يبدو لي أكثر إثارة للقلق لأنه يضفي الشرعية على مفهوم فارغ لواقعية المعايير، وهو مجرد تبرير لمَن هم في السلطة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.




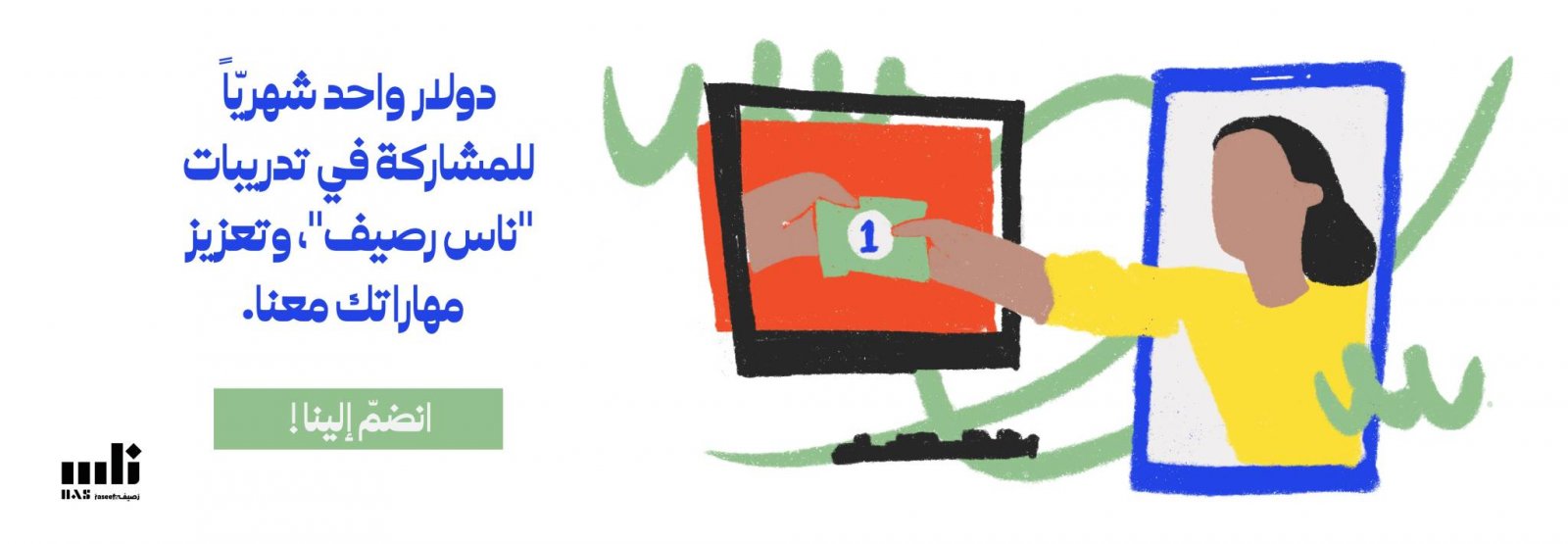

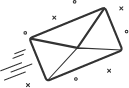
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ 3 أياممدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أياماهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 5 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 5 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار