من منّا لم تُتَح له فرصة، أو ربما الأصحّ: من منّا لم يُرغم على أن يعيش عالقاً في كواليس أمرٍ ما؟ قد يكون هذا الأمر حياة شخص أحبّه، أو حرباً تطحن الأحياء المجاورة، أو الكتابة نفسها.
لطالما كان ما يجري خلف، قبل، وراء الحدث، مغرياً ومثيراً لفضول الإنسان أكثر من الحدث نفسه. اللقطات المقصوصة من الأفلام، فقرة الأخطاء والعثرات في المسلسلات، كاميرا تدور داخل غرف تبديل ملابس الراقصين، الخروج عن النصّ في مسرحية لعادل إمام، النساء اللواتي مررن في حياة رجلٍ وقعن في غرامه للتوّ، وصولاً إلى الانفجار العظيم أو حتّى التفاحة.
قبل أسبوعين انتهت بشكلٍ رسميّ هنا عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الطويلة. في مشواري الصباحي اليومي، راقبت أعمال تفكيك زينة العيد من الشوارع. لفّني حزن غريب من نوعه. شعرت بانسلال البهجة من المدينة، خاصّةً حين مررت بمشهد عودة ألعاب الأطفال إلى أصلها من معدن ومطّاط.
لم تكن المرّة الأولى التي أجد نفسي فيها شاهدةً على كواليس الفعاليات الكثيرة التي تحتضنها بتواتر لافت المدينة التي أقطنها. لم يستغرق الأمر منّي وقتاً طويلاً كي أنتبه إلى أنني ما أن أخرج من البيت حتى أصير داخل بروفات تجري على مسارح تحيط بي كيفما تحركت.
على بعد بنائين من مسكني، يقبع الباب الخلفيّ لمسرح تقام فيه عروض فنية دوريّة متنوّعة، وكثيراً ما مررت براقصات فلامنغو يأخذن سيجارةً قبل بدء العرض، أو يعدّلن شيئاً في المكياج الصاخب. ذكّرني ذلك بصورة شاهدتها قبل سنوات لـ"مريم المجدلية"، تأخذ سيجارتها تحت الصليب، لم أفكر بعد ذلك في مشاهدة الفيلم نفسه. تلك اللقطة التي لن تمرّ على الشاشة كانت كافيةً بالنسبة لي.
قبل أسبوعين انتهت بشكل رسميّ عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. راقبت أعمال تفكيك زينة العيد من الشوارع. لفّني حزن غريب من نوعه حين مررت بمشهد عودة ألعاب الأطفال إلى أصلها من معدن ومطّاط
يتكرّر الأمر على مسارح أخرى يصدف أنها تتفتح على الطرقات التي أقصدها في نزهاتي القصيرة. ها هي فرقة من طفلات صغيرات يلبسن الجبّة المنفوشة فوق بنطال الجينز أو الشورت في أثناء التدريب لحفلٍ تقليديّ لمناسبة قادمة، غالباً دينيّة، على مسرحٍ مفتوحٍ قبالة البحر، في اللّيل يصير غرفة نوم لمشرّدي المدينة، في عرضٍ لا يتوقّف.
الساحة التي كانت سابقاً محطةً لانطلاق الحافلات، وأصبحت اليوم مقهى يجاور حديقةَ أطفال، وفسحةً واسعةً تشغلها بين الفترة والأخرى عروض فنية ومسرحية في الهواء الطلق، مهرجان لطعام الشوارع، ملتقيات لفنانين تشكيليين، معارض كتب... وغيرها، وطوال أيام السنة تكون ملعباً لألواح التزلج والدراجات الهوائية. في هذه الساحة أصير شاهدةً على العملية الفنية منذ مراحلها التأسيسية، حين تصل السيارات المحمّلة بأجهزة الصوت أو الكراسي أو العدة اللازمة لإنشاء مسرح مؤقت. ومرّاتٍ، حين يخلو المكان، أصعد إلى خشبة المسرح، أستمتع بطقطقة الخشب تحت خطواتي، ولا أحد يصفّق لي.
أمّا العروض الحقيقية فقلّما حضرتها. أشعر وكأنني أمضيت يومي في تحضير مائدة العشاء، باذلةً حواسي كلها في سبيل ذلك، لذا حين يتحلّق الجميع حول الطاولة، يمنعني من مشاركتهم شعور وهميّ بالتخمة. الفرق أنني عمليّاً لست جزءاً من هذه الفعاليات، وكل ما هنالك أنّ الكواليس اختارتني كي أعيش فيها، كي أكون شاهدةً على ما يجري قبل الحدث بقليل.
"العالم مسرح
وأنا لست ممثلاً
تلك هي المأساة*".
قبل مدّة، في نزهة يوم الأحد المعتادة، كانت إحدى الفعاليات على وشك البدء، ووجدت نفسي وسط عدد هائلٍ من النّاس يتكلّمون لغةً لا أفهمها، وليس بإمكاني سماعها. لأوّل مرّة أكون وسط ضجيجٍ وصخبٍ، من دون أن يكون له صوت. أذكر أنني في الماضي تعلمت كيف أقول اسمي بلغة الإشارة، وكيف أخبر الآخر بأنني أحبه. فكرت أن هذا بالفعل كلّ ما أحتاجه من اللغات قاطبة: اسمي نسرين، وأنا أحبك.
أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، دُعيت للمشاركة في مهرجان شعري في جزيرة مايوركا. في اليوم السابق للفعالية كان علينا أن نقوم ببروفات العرض، كنت تائهةً ما بين فهم الأحاديث بالكتلانية التي لا أجيدها، وبين إدراك ما سيحصل فعلاً، فمن المعتاد بالنسبة لي في هذا النوع من الفعاليات، أن أتلقى معلومات حول الوقت التقريبي للمشاركة. أختار مادة القراءة مع الحرص الدائم على استهلاك وقت أقلّ، لتشكيل الحروف كلها وكأنني أضع الخواتم في الأصابع النحيلة للكلمات، وأحرص على تدلّي قرطين من أذنيّ قبل أن أبدأ القراءة بصوتٍ خجول، مرتبك، تائه، ثمّ أهبط متأبطةً ذراع ندمٍ جديد.
لطالما كان ما يجري خلف، قبل، وراء الحدث، مغرياً ومثيراً لفضول الإنسان أكثر من الحدث نفسه. اللقطات المقصوصة من الأفلام، فقرة الأخطاء والعثرات في المسلسلات، كاميرا تدور داخل غرف تبديل ملابس الراقصين
في تلك المرة كان الوضع مختلفاً. وجدت نفسي داخل مسرحٍ كبير ومهيب، ووسط فريق عمل يحضّر للحدث. نعم صرت في الكواليس من جديد، لكن ليس كشبح كما اعتدت أن أفعل. فهمت في البداية أن الشعراء المشاركين سوف يجلسون بين الجمهور، ثمّ حين يتم تقديم واحدنا تسلَّط عليه بقعة ضوء ليكتشف الناس أن الشاعر ليس إلاّ واحداً منهم. أراحتني بعض الشيء فكرة أنني لن أكون مضطرةً إلى مواجهة الناس، بل بشكلٍ حميميّ نترقّب معاً ظهور الشعراء بيننا، قبل أن يخبرني مدير الفعالية بأن هذا لن يكون دوري، بل عليّ أن أنتظر وراء الكواليس إلى أن تُفتح الستارة، ثمّ أدفع بنفسي كلماتي العربية إلى الخشبة.
بدأت البروفات، وتلقّي التوجيهات، وتبادل الاقتراحات بيني وبين الموسيقيّ، الدراماتورج، مهندس الصوت والمخرج. كانت آخر القصائد التي حضّرتها للقراءة واحدةً من سلسلة قصائد عن ابنتي، لذا اقترح عليّ المدير أن أختتم فقرتي بالتهويدة التي أدندنها عادةً لابنتي كي تغفو. أخبرته بأنّني أحبّ الغناء بشكلٍ كبير لكنّني سيئة فيه بشكل أكبر، وسيكون الأمر كارثيّاً في حال تجرّأت وفعلتها، لكنّه أصرّ على أنّني سأفعلها كما لو أنّني في غرفة نوم صغيرتي، لا على مسرح... وهذا ما حصل، خرجت من الكواليس ودخلت إلى أحلام ابنتي، وسقط منّي قرطٌ في الطريق.
حينها، انتبهت إلى أن مفردة "نانا" في الإسبانية تعني تهويدة، ونانا هو الاسم الذي أنادى به منذ الطفولة من قبل المقربين منّي، حين يلفظ شخص "نانا" وهو يهمّ بالحديث معي، أعرف أنه سيقول أمراً لطيفاً، لأن الأمور البالغة الجدية أو حتى السيئة، عادةً ما تُستهَلّ بـ"نسرين" كاملةً وحاسمةً من أجل قولها. إذاً من يحبّني من دون أن يدري كان يعدّني تهويدةً، أغنيةً تجلب الاسترخاء والسكينة. أحببت هذا، وأحببت أنني أيضاً ومن دون أن أدري كنت أقوم بواجبات التهويدة كاملةً، حين أحبّ. اسمي نانا، وأنا أحبك.
"لكن فرقاً بين الدمية فوق الخشبة والمشنوق على باب المسرح أو في الكالوس... الحبل هنا كالحبل هناك لكنّ العرض غير العرض*".
*الاقتباسات من أفكار جنونية فى دفتر هاملت، نجيب سرور.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






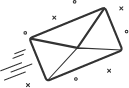
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 16 ساعةجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ يومينمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ يومينفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ يوميناهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار