إن ألقيت نظرة من الأعلى على كوكب الأرض وتمعنت قليلاً، فسترى اليابسة. وإن بحثت قليلاً، فسترى سوريا. وإن دققت في سوريا، فسترى حمص وطرطوس، وما بينهما مدينة اسمها مشتى الحلو. بعد مشتى الحلو بسبعة كيلومترات إلى الأعلى، سترى قرية صغيرة لم يسمع بها أحد من قبل اسمها بقطو، في منتصفها دير، عن يمين الدير بقعة خضراء صغيرة ويتمدد عليها شخص. هذا أنا، أتراني؟
ابق معي قليلاً عسى أن ينزل ثقل الوحدة عن صدري لهذه الليلة، فأتنفس
ابق معي قليلاً عسى أن ينزل ثقل الوحدة عن صدري لهذه الليلة، فأتنفس.
إنني أفترش هذا العشب منذ ساعات وأتأمل سواد السماء ونجومها. قد ينطبق هذا على ما قاله جبران خليل جبران وغنته فيروز: "هل فرشت العشب ليلاً وتلحفت الفضا". ولكنني أخجل أن أغنيها بصوت عالٍ فيسمعني أحدهم ويضحك، فأنا لست زاهداً فيما سيأتي ولا ناسياً ما قد مضى. الزاهد هو من أعتق ملذات الدنيا وأنا ملذات الدنيا لم تمر بجانبي حتى. إضافةً إلى أنني متيقنٌ أنه لن يأتي شيء كي أزهد به. وإن أتى، فسأتمسك به بيديّ وقدميّ. وبالنسبة لما مضى، فالألم لا يُنسى ولو بعد ألف عام.
أستلقي هنا على هذا العشب أتأمل النجوم. أتأمل كيف أنني لن أستطيع الإمساك بها أو حتى الاقتراب منها، تماماً كأصدقائي الذين عرفتهم شخصياً في الأيام القديمة، إضافةً إلى أصدقائي الذين لم ألتق بهم يوماً ولن ألتقي بهم يوماً.
منذ عام 2011، أي في بداية الحرب الأهلية في سوريا، بدأ أصدقائي بالمغادرة واحداً يلي آخر. ولدى وداعهم، كنت أختم كلامي بكلمة: "إلى اللقاء"، مع أنني أعرف مسبقاً أن احتمال لقائنا مرة أخرى شبه معدوم، ولكن تلك الكلمة كانت تبعث بقدر ضئيل من الطمأنينة.
منذ عام 2011، بدأ أصدقائي بالمغادرة واحداً يلي آخر. ولدى وداعهم، كنت أختم كلامي بكلمة: "إلى اللقاء"، مع أنني أعرف مسبقاً أن احتمال لقائنا مرة أخرى شبه معدوم، ولكن تلك الكلمة كانت تبعث بقدر ضئيل من الطمأنينة
عام 2016، كنت قد بت وحيداً تماماً. أصبحت كالعجوز المتقاعد، ولكن بنشاط أكبر ومسؤوليات أعظم. صرت أستيقظ باكراً لأمشي كغريب في شوارع هذه المدينة الفارغة. أمشي بين ينابيعها وأشغل محركات المياه كي تجري المياه في أنهارها وسواقيها. وأثناء عودتي في الليل، أدور بين شوارعها كي أطفئ الأنوار. ثم أعود لأتمدد على أي بقعة صالحة للراحة من البقع القليلة المتبقية في هذه البلاد.
أبدأ بمراسلة أصدقائي كي أطمئن عليهم، إذ باتت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوحيدة التي أستخدمها للتواصل. لم أعد أتواصل مع أحد خارجها إلا في الضرورات القصوى، فحتى الباقون هنا ينتظرون دورهم في الهجرة، وأخاف أن أتعلق بأحدهم ويغادر فيفطر قلبي مجدداً.
اعتدت فكرة التواصل مع أناس عرفتهم مسبقاً ولن أراهم مجدداً، فمنهم من لجأ إلى ألمانيا، ومنهم من بات في فرنسا والآخر في أستراليا وذاك في الإمارات وتلك في أمريكا. ولا أزال أحتفظ بصورتهم ذاتها في ذاكرتي مهما تغيرت ملامحهم. وما زلت أتكلم معهم وكأنهم قريبون مني جداً، فكلما كلمتهم أشرع في للشرح لهم عن افتتاح متجر جديد للألعاب في تلك "الزاروبة" الضيقة، أو المكان الضيق، من الشارع الصغير في الحي الشعبي الذي اعتدنا أن نلعب فيه كرة القدم. وهم يجارونني في الحديث وكأنهم لا يزالون يتذكرون تلك الشوارع أو يكترثون لأمر الألعاب تلك حتى يكترثوا لافتتاح متجر لها.
اعتدت فكرة التواصل مع أناس عرفتهم مسبقاً ولن أراهم مجدداً، فمنهم من لجأ إلى ألمانيا، ومنهم من بات في فرنسا والآخر في أستراليا وذاك في الإمارات وتلك في أمريكا. ولا أزال أحتفظ بصورتهم ذاتها في ذاكرتي مهما تغيرت ملامحهم
ولطالما أخفيت عنهم أمر أن تلك "الزواريب" الضيقة قد هدمت والحي بأكمله تغيرت ملامحه تماماً.
لكن ما لم أظن أنني سأعتاده حقاً هو أن يصبح لدي أصدقاء لم أرهم شخصياً ولا حتى ليوم واحد في حياتي، وهذا ما حدث حقاً. فقد جمعتني الصدف والاهتمامات بأصدقاء لم أعرفهم سابقاً، مع أن بعضهم من نفس المدينة، بل بعضهم من نفس الحي الذي أقطن فيه ولم يسبق أن ألتقي بهم ولا أظن أنني سألتقي بهم يوماً.
نتحدث يومياً وكأننا أعز الأصدقاء، وكأننا مشينا يوماً معاً في شوارع هذه المدينة، وحين تصيبني نوبات الاكتئاب تلك لا يكفون عن دعمي والتواصل معي. وبعضهم تعدى دعمه المعنوي إلى أن أصبح مادياً في بعض الأحيان. وحين تواجههم المشكلات، يلجؤون إليّ وكأنني خبير لوجستيات معتمد من جميع مؤسسات العالم.
ما لم أظن أنني سأعتاده حقاً هو أن يصبح لدي أصدقاء لم أرهم شخصياً ولا حتى ليوم واحد في حياتي
نمازح بعضنا بعضاً يومياً بنكات مثل: "تعال إلى ألمانيا وسأدعوك إلى كأس من البيرة الباردة"، أو "تعال إلى أمريكا وسأحضر لك وجبة هابي ميل".
وأنا أجيب: "تعالوا إلى سوريا وسأدعوكم إلى وجبة من أفخاذ السمك المشوية"، فعودتهم إلى سوريا أو ذهابي إلى الخارج هو أمر خيالي تماماً كأفخاذ السمك. ثم نعاتب بعضنا بعضاً لأننا لم نلتق قبل وباء الهجرة ذاك الذي أصاب شعبنا. وبعد ذلك، أغلق المحادثة وأكتم دموعي التي كادت أن تنهمر شوقاً لمن لم ألتق بهم يوماً.
لا أعلم ماهية هذه الحياة التي نعيشها! هل هي طريقة للتكفير عن الذنوب التي اقترفها أجدادنا سابقاً أم أن هذه الأرض ملعونة بالفراق وحسب؟ فحسبما أرى، لم تكن إرادة الله أن ينتشر الياسمين عبر أصقاع العالم كما يُشاع، بل كان عقابه لنا أن تتقطع قلوبنا شوقاً لمن لم نلتق بهم يوماً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






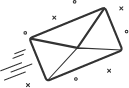
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 16 ساعةجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ يومينمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ يومينفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ يوميناهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار