أحد أقدم أشكال إذلال الفرد وكسر عزيمته و تغريبه عن ذاته تتمثل بإجباره على "العمل". ألم تكن العبوديّة ذاتها نظاماً اقتصادياً هدفه أن "تعمل" فئة كي "لا تعمل " أخرى؟ ألم يتحول "العمل" لاحقاً إلى قيمة جوهرية في الحياة تضمنها الدولة وتنشأ على أساسها الأسرة؟
الأسئلة السابقة وصيغتها البلاغيّة والوعظيّة، لا تكفي لنفي أهمية العمل وضرورته، وهذا ما نقرأه في مقدمة كتاب "ضد العمل- تحقيقات نفسية في حقائق ضد العمل ومشاكله و حلولها" الصادر بداية هذا العام عن دار روتليدج، وفيه يناقش جورج م.اليجير، "أفكاراً" ضد العمل، كون هذه الفرضية لا تشكل قطاعاً أو مدخلاً اكاديمياً مستقلاً، كون العمل الآن شأناً لا نقاش فيه، مهما كان مهيناً أو متعباً فلابد منه، فهو "قيمة" حياتنا كما في الأدبيات التقليديّة. لكن، مهما تلاعبنا بالكلمات وأسلوب إدارة المؤسسات، حتى لو نحب "عملنا" وقلنا أنه "عمل أحلامنا"، يبقى العمل شأناً لا نريده، "غريباً" عنا، يخالف حريتنا، ويقدم منفعة لمُشغلنا أكثر مما ننال نحن، والأهم، أن نكون بلا عمل، لا يعني فقط أننا لن نستطيع تحقيق أنفسنا، بل لن نمتلك مقومات الحياة.
أحد أقدم أشكال إذلال الفرد وكسر عزيمته و تغريبه عن ذاته تتمثل بإجباره على "العمل"
يناقش الكتاب الأبعاد النفسية المختلفة للعمل وما يدور في خلد معارضيه، بوصفه مشكلة طارئةً على حياة الأفراد، لا أساس بنائهم أو قمة حياتهم، فهو لا يناقش صعوبات العمل، بل "العمل" كأمر مضطرين للقيام به، لذا حسب الكتاب، لا يوجد تعريف محدد لـ"ضد العمل"، وهذا ما نراه في أسلوب المناقشة، اقتباسات متنوعة من قطاعات عديدة ترتبط بالنظرية السياسية والاقتصاد ونظريات إدارة مؤسسات علم النفس، لكن الملفت أن الكتاب يقدم لنا ما يسميه بـ18 عشر وصية أو Tenets، تلخص الأفكار التي تدور في خلد كل "عامل"، ويتبنى بعضها أو كلها المناهضون لـ"العمل"، أما السبب في هذا "التشتت" ضمن خطاب "ضد العمل"، أننا أمام فكرة تعرضت للنفي بشدة في التاريخ وحورب الداعون لها، وما زلنا إلى الآن ننظر بازدراء إلى من يرفض "العمل".
لن نحاول ادعاء فهم النظرية الاقتصاديّة، ولا التيارات المختلفة للعمل وشروطه، خصوصاً أن الكتاب متشعّب الاختصاصات، لذا ما سنقوم به هو ترجمة هذه "الوصايا" المكتوبة بلغة بسيطة وأحياناً مستفزة، كونها تذكرنا بـ"عملنا"، ثم اقتباس بعض من شرحها وإضافة تعليقاتنا الخاصة، خصوصاً أننا نهاية، أي بعد قراءتها كلها ومقارنتها مع "تاريخنا المهني"، نكتشف أننا نعمل بلا جدوى، ودون قدرة على ترك العمل، سواء كان الواحد منا عامل منجم، موظفاً في هيئة الإسكان، صحفياً، أستاذ جامعة، فناناً، ما يعني أننا لن نعلق في حيثية كل "عمل"، بل نترك لكل قارئ حرية ومأساة المقارنة بين ما يقرأه وما يعمله.
ألم تكن العبوديّة ذاتها نظاماً اقتصادياً هدفه أن "تعمل" فئة كي "لا تعمل " أخرى؟ ألم يتحول "العمل" لاحقاً إلى قيمة جوهرية في الحياة تضمنها الدولة وتنشأ على أساسها الأسرة؟
لابد أن نشير نهايةً أن كلمة "قيمة" التي تتكرر في الوصايا قد تبدو غامضة، لكننا نتحدث بالمعنى المجرد، ومن الممكن القول إن القيمة التي تدافع عنها أفكار "ضد العمل" هي الحرية، وامتلاك مقومات الحياة دون أن نبيع وقتنا وجهدنا مقابلها، هذه الوصايا قد لا تنطبق بكليتها على "جميع" الأعمال، لكن لا ينفي أن قراءتها محزنة، وتدفعنا لإعادة التفكير في كل ما نقوم به.
1. العمل يتطلب الخضوع، ما يؤذي النفس البشريّة
المقصود بالخضوع هنا هو اضطرارنا إلى فعل ما لم نكن سنفعله لو كنا أحراراً، ولا نتحدث هنا فقط عن الذهاب إلى العمل، بل أسلوب ممارسة العمل نفسه، وإن كنا نتحدث عن وظيفة لا نحبها، فهذا الخضوع يتمثل بـ"العمل" بأكمله، كل الجهد المبذول دون حب أو متعة أشبه بـ"تعذيب" يومي، هذا الأذى للنفس يتمثل بفقدان الإرادة، أي عدم القدرة على عدم فعل ما نكره، والاستمرار به لأجل النجاة.
2. العمل كشأن "جيد" ليس إلا اختراعاً حداثياً وتطوراً مؤذياً
مفهوم العمل كقيمة "إيجابية" ينتمي للعصور الحديثة إن صح القول، والقيم المضافة عليه نتاج الشركات والمؤسسات والأيديولوجيا، الذي حولته من شأن هامشي في حياتنا إلى جوهرها، قبل ذلك كان عقاباً، أو شكلاً من أشكال الإهانة، لكنه تحول الآن إلى ضابط لإيقاع الحياة، الذي تضبطه الآلة والإنتاج، لا علاقة له بالكرامة والجدوى والمعنى في حياتنا.
3. الملل، والضجر والتكرار هي الخصائص التي يوصف بها معظم الوقت الذي نقضيه ونحن نعمل مهما كانت وظائفنا
يقضي البعض سنوات أحياناً يمارس أعمالاً لا تحمل قيمة في ذاتها، بل تستهلك "الوقت" على الأقل دون اكتساب أي مهارة، بل إن بعضنا يشغل مناصب وهمية، أعمالاً لا قيمة حقيقة لها، والمرعب هو أن البعض "يطور" مهارات لا حاجة له بها أبدا خارج أوقات العمل، وقد ينشأ تشوهات جسدية أو "انحرافات" سببها ممارسة هذا العمل المتكرر، أشبه بتمرين لا فائدة منه، تكتسب أجسادنا "شكل" تنفيذه بصورة مثالية دون أن يكون له أي فائدة خارج خط الإنتاج.
مهما تلاعبنا بالكلمات وأسلوب إدارة المؤسسات، حتى لو نحب "عملنا" وقلنا أنه "عمل أحلامنا"، يبقى العمل شأناً لا نريده، "غريباً" عنا يخالف حريتنا ويقدم منفعة لمُشغلنا أكثر مما ننال نحن
حتى لو كان البعض يحب عمله، هناك أجزاء ومهام مملة، ومتكررة وأحياناً بلا قيمة، لكن لا يمكن تفاديها، كانتظار الباص صباحاً للتوجه إلى العمل، أو إن كنت تعمل من المنزل، اجتماع الصباح الممل مع الزملاء حيث الكل يتثاءب، هذا إن لم نتحدث عن "الممل" والتكرار أثناء العمل ذاته.
4. العمل وجهة نظر ذاتيّة بلا معنى ويؤدي إلى "الاغتراب" بسبب نقص التواصل بين العمال وبين المؤسسة وأهدافها ونتائجها
يشير الكتاب إلى أن هذا الانتقاد جوهر الماركسيّة، خصوصاً أن "العمال " مهما مارسوا من مهن، صحفيين، عمال مصانع، حفاري مناجم، حفاري قبور، لا يرون أن النتيجة النهائية هي جزء من أنفسهم أو انعكاس لعملهم، فالعامل يُدمر جسده وعقله لأجل نتيجة لا يرضى عنها أو عن كُليتها، وكأن "عمله" ذو نتائج لا تنتمي إلى داخله.
تتضح الآثار النفسية للاغتراب لدى من يعملون في منظمات كبرى أو مؤسسات الدولة، كونهم لا يستطيعون "امتلاك" المنتج النهائي، أو نسبه لأنفسهم بشكل كامل، وفي ظل تقسيم العمل، تفاني "الواحد" في عمله لا يعني أن نتيجة "الكل" تتطابق مع هذا التفاني الفردي، ناهيك أن هذا "الاغتراب" لا يحضر فقط في العمل، بل ينتقل إلى المنزل الذي يتحول إلى "استراحة من العمل".
5. العمل من وجهة نظر موضوعيّة، دون معنى، كونه بشكل قصدي يؤدي إلى خلق رغبات لا نحتاجها من أجل أن يستهلكها العامة، ما يعني أننا في النهاية نُنتج سلعاً وخدمات لا معقولة ولا نحتاجها، ما يؤدي إلى جعل أعمالنا بلا معنى
يبدو للوهلة الأولى أن هذه "الوصية" تنطبق على السياق الرأسمالي فقط، لكن يمكن سحبها على الأنظمة الشمولية والاشتراكيّة، فهناك مؤسسات بأكملها تعمل دون فائدة "حقيقية"، ما الذي تؤمنه مثلاً مؤسسة مثل المخابرات العامة من خدمات نحتاجها فعلاً؟ ذات الأمر مع شركات تصميم التطبيقات التي تنتج ألعاب الموبايل التي ندمنها وندفع ثمنها ثم ننساها؟ كلها نماذج لأعمال لا ينتج منها ما هو "ذو معنى" ، بل أغراض نستهلكها وأدوار نلعبها ووظائف نشغلها من أجل رغبات "صُنعت" كي نستهلك، لا كي نجد المعنى.
الادّعاء أن الكثير من المؤسسات موجودة لإنجاز أعمال لا نحتاج لها مثير للاهتمام، ويتضح الأمر حين نراقب بعض "الأعمال" التي لا نعلم "قيمة" وجودها، بصورة أدق، لا نعلم ما تقدمه لنا، كوننا نعلم أنها "تفيد" صاحب العمل للتحكم برغباتنا وخوفنا ومشاعرنا، مثل مراقب الدوام، أو محلل بيانات المشتركين، الموظفان اللذان يبذلان جهداً/ يعملان من أجل إنتاج نظام مراقبة وتجسس يخدم "الرئيس". هذا العمل بالذات بلا معنى، لأن من يقوم به لا يمتلك أي شيء منه، هو فقط يسهل السيطرة على الآخرين ليشتروا أكثر.
مفهوم العمل كقيمة "إيجابية" ينتمي للعصور الحديثة، والقيم المضافة عليه نتاج الشركات والمؤسسات والأيديولوجيا، الذي حولته من شأن هامشي في حياتنا إلى جوهرها
6. العمل استغلالي، إذ يتم الاستغلال العمال بالضرورة والاستفادة منهم، سواء ادعوا أنهم يحبون عملهم أو لا. في الجوهر، المؤسسات والمالكون، يكسبون من فائض القيمة وتدفع للعمال أقل من قيمة عملهم
هذه الحجة متكررة دوماً، الأجر الذي نتقاضاه على "جهدنا" غير عادل بالضرورة، نُحن نُستغلّ بشكل أو بآخر كي يربح رب العمل، حتى لو كان الواحد منا يعمل بما يحلم به، الاستغلال قائم بسبب "شكل العمل" نفسه، فمنذ نظام العبودية إلى الآن، لم يتساوَ الجهد الفردي مع المردود، ويشير الكتاب إلى أن الرأسمالية عملت على تغيير العلاقة مع "القيمة".
قيمة السلعة/ الخدمة لا تأتي من الجهد المبذول في عملية إنتاجه/ها، بل من الرغبة الجمعية به/ها، أي نُقلت القيمة مع "جهد العامل" إلى "رغبة المستهلك" التي يمكن التحكم بها وخلقها.
7. يمكن القول إن العمال يستغلون أنفسهم
هذه الوصية تقوم على أساس أن العمال أنفسهم يختارون العمل، وهنا تأتي أدبيات ضد العمل لتبين أن هذا الخيار بحد ذاته مشكلة، إذ فجأة يجد العامل نفسه مضطراً لمراقبة سلوكه وإنتاجيته وقدرته على بذل الجهد، هذه السردية نشأت مع حركات تثقيف العمال، الذين يقع عليهم اللوم كونهم لم يحسنوا شروط العمل أو لم يطالبوا بتغييرها، ليظهروا وكأنهم يستغلون أنفسهم دون دراية، في تجاهل لقيمة العمل وجدواه وآثاره النفسية.
هذا الاتهام الذي يوجّه للعامل لا يناقش "مشكلة" العمل، بل كيفية الحفاظ عليه دون "استغلال"، وهنا التناقض، لا عمل دون استغلال ومبادلة الجهد العضلي أو الفكري بثمن لا يتطابق مع هذا الجهد.
8. العمال خاضعون لنظام مؤسساتي عقابي وسلطوي، أينما كان مكان العمل، سواء كانوا ينجزون مهامهم أو لا، سواء كانوا من أصحاب الياقات الزرقاء أو البيضاء، سواء عملوا بدوام كامل أو نصف دوام، سواء كانوا موظفين أو متعاقدين، الكل "يخضع"
المقصود هنا أن نظام العمل ومؤسساته تطالب من الموظفين والعمال التنازل عن حقوق تضمنها الدولة، ويخضعون لأنظمة مقارنة وتقييم وعقاب وهرميّة تصل أحياناً حد انتهاك حقوقهم، الملفـت، هو التسليم بالخضوع لهذه الهرمية التي لا مفر منها، الهرمية التي تشابه دولة صاحبها "رجل"، يحكم الناس لـ"خدمته".
ما حصل بعد جائحة كوفيد 19، ونحن نعمل من منازلنا، أننا اكتشفنا الهرمية الخفية للمؤسسة، أو "المؤسسة العميقة" تلك التي يتخذ فيها القرار الحقيقي و يتم على أساسه العمل، وكشفت تقنيات المراقبة والتقييم والاستغناء عن الكثير من الموظفين، ما جعل الأغلبية تعود للهيكلية التقليدية، مدير وموظف ومراقب دوام.
9. المؤسسات تعمل وكأنها "حكومات خاصة" ما يتطلب تقييد للحريات والحقوق التي عادة ما تضمنها أو تصادرها الحكومة الرسميّة
المقصود ببساطة أننا نتنازل للمؤسسة العمل عن حقوقنا وحرياتنا، مثل حق النقاش، رفض التنفيذ، معرفة سبب الطرد وغيرها، كلها حقوق تصادرها المؤسسة بشكل ما، بالرغم من أننا نمتلكها في ظل الدولة، لكنها غير موجودة ضمن فضاء العمل، ناهيك عن انتهاك الخصوصيّة. وبالرغم من الكثير من القوانين التي تمنع هذا الشكل من الانتهاك، كقانونيّة عدم الرد على البريد الإلكتروني أو الرسائل التي نتلقاها من المدراء أثناء العطلة في فرنسا، لكن أثر هذه التنازلات ما زال قائماً، ولو على المستوى النفسي، أيمكن مثلاً أن يتجاهل الواحد منا هاتفاً من مديره في يوم العطلة؟
الاعتقاد بأن الأفراد يتم اختيارهم لتوظيفهم أو ترقيتهم بناء على "جدارتهم" مُضلّل. واختبارات قياس الأداء في العمل ليست عادلة ولا حاسمة إنما تروج لعدم المساواة
10. العمل يُنجز ضمن بيئة الثقة فيها منخفضة جداً ومليئة بالشك المتبادل بين الموظفين والمدراء
يمكن القول إن بيئة العمل عدوانيّة، لا أحد يثق بأحد، خصوصاً في المؤسسات التي يُجزّأ فيها العمل، انعدام الثقة هذا أسبابه متنوعة، قد لا تكون بسبب اختلاف المهارات، بل المنافسة على المكاسب والفرص المتاحة والترقيات، فالجميع يترقب الجميع، خصوصاً في مؤسسات لا يمتلك فيها العمل قيمة له أو لا يتصل بجسد العامل، كالموظفين في مؤسسات الدولة، وحتى لو كنا نتحدث عن أشد شركات وادي السيلكيون انفتاحاً و تعاوناً وثقةً، من منا لم يحاول أن ينال من زميله من أجل ترقية أو يوم عطلة أو نقود أكثر، وهذا بالضبط واحد من إشكاليات العمل، التنافس داخل المؤسسة الواحدة والعداوة، يكون في أغلب الأحيان لسبب يثير المفارقة "التقليل من العمل" أو "نيل قيمة أكثر على الجهد المبذول".
11. العمل "يستعمر" حيوات الموظفين وينتقل معهم إلى المنزل
هذه الوصية تقليدية في أدبيات ضد العمل، ويمكن التوسع في قراءتها حين الاطلاع على انتقادات مدرسة فرانكفورت لمفهوم زمن الفراغ، ولا نتحدث فقط عن الصناعة الثقافية ودور الأيديولوجيا، بل تحول المنزل إلى مساحة للاستعداد للعمل وترسيخه أخلاقيته، ما يُفقد المنزل قيمته كمكان للاسترخاء والانقطاع عن الفضاء العام والأداء الرسمي، ليتحول إلى مساحة استعداد وشحن للطاقة من أجل يوم عمل جديد، ناهيك عن تحول المنزل إلى مساحة لمتابعة العمل أو إتمامه خارج وقت "الدوام"، الشأن الذي تعمّق في ظل الجائحة، وتحول إثر ذلك المنزل إلى "مكتب"، صحيح أن البعض يمتلك روتيناً خاصاً من أجل فصل زمن العمل عن زمن اللاعمل، لكن هل يمكن فعلاً رسم حد واضح بينهما؟ أليس وجود "أدوات العمل" في المنزل بحد ذاته مصدراً للقلق؟
12. العمال يعانون ويقاومون -وأحياناً بشكل عفوي- من أجل التقليل من آثار العمل على أنفسهم وحيواتهم بمستويات مختلفة ومعدلات متنوعة من النجاح
هذه المقاومة التي تتطلب أحياناً شجاعة تكشف عن مدى انتهاك العمل لنا، خصوصاً أنه يومي و متكرر ويفقد نكهته بسرعة، وقد يتحول هذا الأسلوب من "المقاومة" إلى لعبة مطاردة بين المدراء والعاملين، فالمدراء يفضلون أن نكون دوماً "نعمل" في حين أننا نقاوم ذلك، نتهرب، نتكاسل، وأحياناً نتناسى، صحيح أن التكنولوجيا الجديدة وفرت أساليب لمراقبة أعمالنا و زمن عملنا و"أدائنا"، لكن الأمر ليس طارئاً أو جديداً، بل موجود مسبقاً، فمراقب الدوام ذاته ما زال حاضراً في الكثير من المؤسسات، في حين أن بعضها فضلت استبداله بنظام البصمة التي نسجلها في كل مرة ندخل فيها "المؤسسة".
يمكن أن تصبح المقاومة أحياناً مايكرويّة، كإطالة وقت الاستراحة المسموح أو زيادة عدد السجائر التي ندخنها خارجاً، وهذا ما يسمى التأكيد على الاستقلالية، وأننا أفراد ذوي مزاج و تقلبات نفسية وشخصيات مختلفة، نقف بمواجهة بعض المؤسسات التي تمنع استخدام حواسيبها مثلاً لأغراض شخصية، كتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو إرسال بريد شخصي، صحيح أن هذه الممارسات قد تبدو إضاعة للوقت، أو استغلالاً للمؤسسة أو تقصيراً، لكن منعها بحد ذاته تهديد لنا، كم هو مهم هذ العمل الذي علي أن أقضي 8 ساعات يومياً لا أفعل شيئاً سوى العمل والعمل ثم العمل مجدداً، إلى حد دقيقة الانتهاء التي أهرب فيها من المكتب ؟ هل هذا وصف للعمل أو "التعذيب"؟
المجتمع عبر نظامه الاقتصادي والترفيهي والتعليمي وأعرافه يجهز أعضاءه لقبول العمل كالأسلوب الوحيد للحياة
13. هناك تفسير يمكن استخدامه حين الحديث عن الأماكن/ الوظائف التي توصف بأن تجربة العمل فيها مثيرةً للاهتمام وتخلق نوعاً من الانتماء. التفسير هو أننا أمام إدارة جيدة تتبنى التلاعب النفسي بمشاعر ومواقف العاملين من خلال توجيههم و تحسين ظروف عملهم و مكافاتهم
يشير الكتاب إلى "المتخيلات" التي تنتشر بكثرة عن إمكانية جعل العمل ممتعاً أو مثيراً للاهتمام أو يحقق الذات أو تحول الموظف إلى "شريك في المؤسسة"، هذه المتخيلات تقوم على أساس إعادة ترتيب وهيكلة شكل العمل ليصبح الموظف/ العامل مُنتجاً أكثر، أو أقل كسلاً، هي تعديلات إيجابية من أجل زيادة الإنتاجية والرفق بـ"مشاعر" الموظفين.
تكتسب كلمة "متخيلات" السابقة معناها السلبي، لأنها لا تتناول المشكلة الرئيسية، "العمل"، الذي مهما كانت شروطه وشكله يحافظ على كونه "عملاً"، هذا التناقض يخلق الكثير من "الأوهام" لدى الموظفين، التي تستخدم كأسلوب إداري لتحويل الاستغلال الذي تمارسه المؤسسة إلى استغلال داخلي، أي أن العامل نفسه لا يجيد التعبير عن شروط العمل المناسبة له، بالتالي المشكلة فيه لا في العمل نفسه.
14. الاعتقاد بأن الأفراد يتم اختيارهم لتوظيفهم أو ترقيتهم بناء على "جدارتهم" مُضلل. واختبارات قياس الأداء في العمل ليست عادلة ولا حاسمة، وتروج ببساطة لعدم المساواة
كلنا نختبر في حياتنا المهنية لحظة نشهد فيها على توظيف أو ترقية أحدهم دون أي سبب، شخص لا يتمتع بالمهارات الكافية لكنه فجأة أصبح مديراً أو حتى موظفاً، هذه الفئة نقول بوضوح بأنهم "حمقى" ولا يستحقون احترامنا، لكنا اضطررنا للعمل معهم، كل هذا سببه كلمة "الجدارة" هذا الشخص يستحق أو هو في المكان المناسب.
في الكثير من الأحيان هذه "الجدارة" لا تتعلق بالوظيفة نفسها، بل بما يحيط من الشخص من هالة أو بسبب خصائصه الشخصية وسلوكه. الأمثلة الأوضح تتجلى في التحيز الجنسي والتمييز على أساس اللون، وفي هذه الحالات الكفاءة والجدارة تتلاشيان على حساب سياسة المؤسسة أو قرار من قام بالتعيين.
الملفت أن هذه الوصية تقسم "العمال" ضمن المؤسسة إلى من يجيدون العمل وإلى المتسلقين أو الحمقى، ما يخلق أول عداوة، ويتغير العمل ليصبح محاولة للنجاة وكسب المزيد والتقليل من العمل، مع العلم أن هذين الفريقين يدعيان على السواء أنهم "الأفضل".
15. المجتمع عبر نظامه الاقتصادي والترفيهي والتعليمي وأعرافه يجهز أعضاءه لقبول العمل كالأسلوب الوحيد للحياة
هذه المقاربة هي واحدة من دعائم أفكار ضد العمل، والتي ترى أن شكل العالم في ظل السلطة السياسية القائمة يجهز الأفراد كي يعملوا ويستهلكوا أكثر، سواء أحبوا أو لم يحبوا أعمالهم، وسواء رغبوا بما يستهلكونه أو لم يرغبوا، لأنهم دون العمل خارج "المجتمع" ولا يساهمون في بنائه، فمسؤولية الفرد تعود نتائجها على الجميع، ولا مجال لرفض العمل، ويظهر التلاعب النفسي والتجهيز البدني هنا عبر المدرسة والشاشة، والحكايات والأفلام التي تنتجها الشركات الكبرى، فالعمل "أيديولوجيا" ديناميكيّة متغيرة، تطبق خارج وداخل أوقات العمل.
16. النظام الاقتصادي الذي ندعوه بـ"الرأسمالية" تمكن على مدى التاريخ من التأقلم مع كل التغيرات في السياسة والتكنولوجيا والتفضيلات الخاصة والعامة في سبيل الحفاظ العلاقة التالية: "المدير يهيمن على الموظف" في ذات الوقت "الرأسمالية الحداثيّة" تجعل التضامن أصعب عبر تفتيت المجتمع
لن نتوسع هنا في شرح هذه الوصية، لكن يمكن القول باختصار إن الرأسمالية ما زالت مستمرة، تغير شكلها دوماً، نبوءة ماركس بأنها تلتهم نفسها لم تتحقق، أي لم ينهر النظام الرأسمالي، بل غيّر شكله وأساليب استغلاله للناس، لتتجاوز جدران الشركة نحو المجتمعات بأكملها، ألسنا كلنا نهايةً "نعمل" لدى فيسبوك؟
أيضاً تفتت الرأسمالية المجتمع عبر تحويل كل واحد منا إلى حالة خاصة فريدة لا تتكرر، له صوره و بروفايله وصفحته، وإن مرض له علاجه الخاص وجلساته الخاصة به وحده، دون أي حديث عن "الفصام " الذي يسببه النظام الرأسمالي، المرض الذي نعاني منه جميعاً، وحتى من يحاول أن "يهرب" ويعمل وحيداً، لن ينجوا من هذا المرض، كحالة الفريلانسرز وسائقي الأوبر.
17. ولو أراد الأفراد أن يعملوا، هذا لا يعني أن "العمل" جيد
يقدم العمل على أنه الخيار الوحيد في الحياة من أجل النجاح أو على الأقل الحفاظ على الحياة، دون أي تفكير جدي بأنظمة اقتصادية وسياسية بديلة، لا يقدم فيها العمل على أنه القيمة الجوهرية للحياة، صحيح أن الكثير من الشركات تحاول جعل العمل مسلياً وممتعاً، بل أشبه بالذهاب إلى مدينة الملاهي، لكنه نهاية عمل، يحوي كل ما سبق من استغلال وتوتر وضغط نفسي و عداوة دائمة، ناهيك أن "الرغبة بالعمل" نفسها ليست جوهرية في أنفسنا، هي رغبة مصنّعة بحكم السياسية والحاجة إلى البقاء.
18. هناك بعض الأساليب البديلة لبناء العالم وتنظيمه دون أن يكون العمل هو الجوهر، أو دون أن يكون سيئاً أو دون الكثير من المساوئ التي يحويها الآن
يشير الكتاب أن إحدى أبرز تحديات "ضد العمل" هي عجزه عن تقديم بدائل واقعية عن الشكل الحالي للعالم، وعدم قدرته على حل مشكلة "العمل" نفسها، بل يكتفي بأمثلة يوتوبيّة، لكن، ربما تحوي هذه النماذج اليوتوبية ما يستحق التصديق، كالدخل العالمي ومجانية بعض الخدمات، أو التعاون على المهن الضرورية بين الجميع، على الكل أن يجمع القمامة في لحظة ما من مسيرته المهنيّة.
الملفت أن عالم "ضد العمل" المثالي لا ينفي العمل أو يغيبه، بل يغير من شكله وقواعده، والأهم يسعى لمهاجمة البنى التي تجعل القيمة الاجتماعية والسياسية والمادية تأتي من العمل، صحيح أن هذا التفكير أناركي، لكن، ألا يعني تحررنا من ضرورة العمل لأجل المسكن والأكل والشرب والطبابة أننا نمتلك الوقت لنفكر، لنتعلم، لنمارس هواياتنا.
ما يرعب مفكرو العمل في التخيلات اليوتوبيّة أنها تهشم صيغة الإنسان العامل-العبد، وتتركه حراً ليلعب لا ليعمل، وهنا الخطورة الأهم، اللعب ذو نتائج مباشرة، تعود على جسد و نفس من يلعب، بعكس العمل، نتائجه ملك للمدير لا الموظف.
ملاحظة أخيرة: هذه الوصايا الـ18 تنطبق كلها على المستقلين أو الفريلانسرز، هم أشبه بـ"مياومين"، يعملون باليوم أو القطعة بالمعنى الحرفي للكلمة، ما يتقاضوه أقل حكماً من جهدهم المبذول، ويضطرون لصرفه على مقومات العمل المستقل نفسها، الكهرباء، القهوة، المواصلات، الصحة النفسية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.




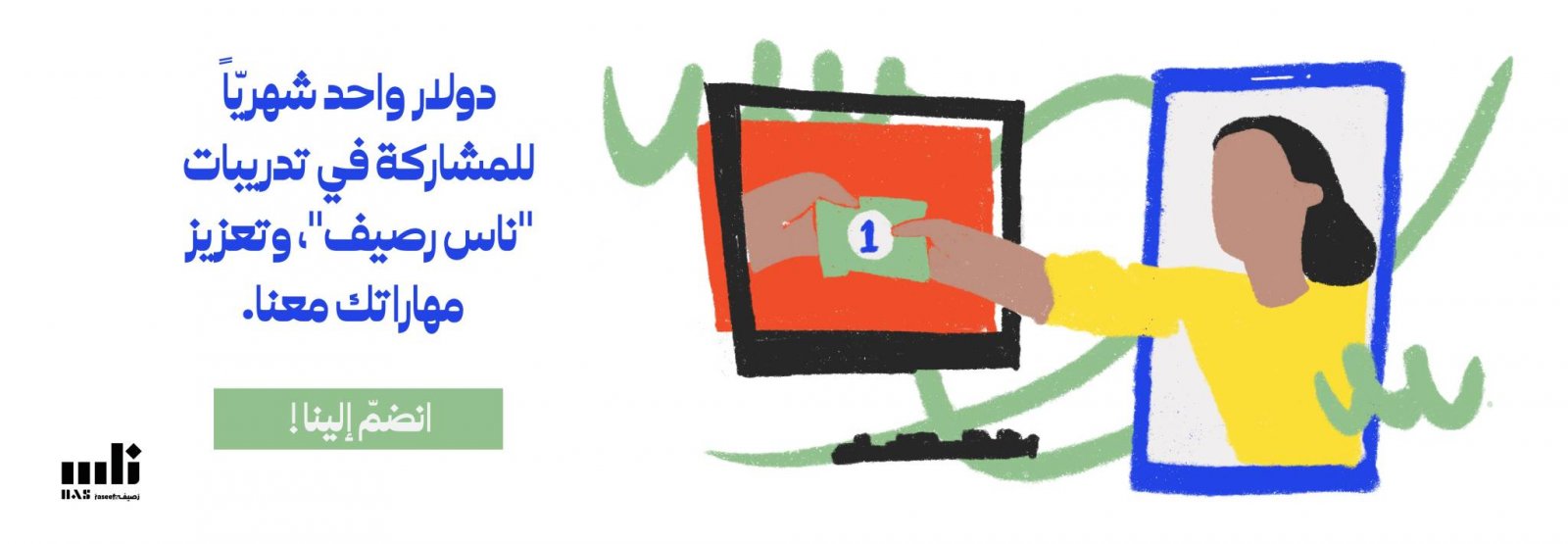

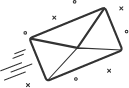
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومتعليقا على ماذكره بالمنشور فإن لدولة الإمارات وأذكر منها دبي بالتحديد لديها منظومة أحترام كبار...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامUn message privé pour l'écrivain svp débloquer moi sur Facebook
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ 4 أيامأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ 4 أيام❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 6 أيامجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...