يحمل الحب المرء إلى الجنون، وقد يحمله إلى الحرب أحياناً، لتكون ثمة حكايات رومانسية يمكن أن نتلوها لصغارنا في ليالٍ يكون فيها للسمر مكان. وكنت أحسب أن حكاية العشق التي عاشها أبي في ستينيات القرن الماضي، واحدة من حكايات شهرزاد، حرّفتها عمتي، وأعادت رسمها بما يتناسب وتحويل أخيها إلى "بطل"، فهو أحبّ بنت جيرانهم (الأسرة الأرمنية قليلة الاحتكاك بمحيطها)، وشريكته في الصف، وحالت "لعنة الدم" دون أن يكونا بطلي عرس مهيب في الحي. لكن الحب دفعه للهرب بها إلى لبنان، وهناك بقي مقاتلاً في صفوف إحدى الفصائل الفلسطينية إلى أن توفيت "ماري"، وابنهما "يعرب"، في قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان، كان يتمركز فيها الفصيل الذي كان قد انضم إليه. ولأن التقاليد تقضي بأن يعود بنبأ الوفاة، حمل جثمانيهما، وعاد إلى أقصى الشمال الشرقي لسوريا ليدفنهما هناك، وعجز عن إتمام ما جاء له بعد الدفن، فعائلة ماري هربت من المدينة نحو دولة أوروبية، بعد أن أنهكتها عيون أبناء المدينة وهي ترجم العائلة بالعار، وهو عار ما كان ليُمحى إلا ودم "ماري" يسيل على سكين أحد إخوتها الثلاثة.
كنت حذراً من الوقوع في هذا الفخ، حتى أحببت "درزيةً"، بهذه البساطة، ومن دون مقدمات، وبت أرسم خططاً لنؤسس لحراك مدني انطلاقاً من العشق، ونصرته.
ظلت الحكاية بالنسبة إلي نوعاً من محاولات عماتي لتبرير انكسار أخيهن الدائم، فهو يميل إلى العزلة حتى بعد انشغاله بعائلة أسسها وأمي، وكنت أظن أن المرء يميل بطبعه إلى الكذب، ليخفي ما لا يريدنا أن نعرفه. ولم أعرف قبل وفاته ودخولي والشيخ لمتابعة طقس غسله والكفن، أن في جسده أثراً لأربع رصاصات قديمة، وهناك بدأت الأسئلة حول هذه الرصاصات، لكن ربطاً منطقياً بتزامن سنوات خدمته الإلزامية مع مرحلة حرب تشرين/ أكتوبر من العام 1973، أنهى الأسئلة، لأستقيم في الصف الأول للمصلّين على جثمانه، وكنت أظن أن حكاية هذا الإنسان الذي هو أبي، ستنتهي بنهاية أيام العزاء الثلاثة المعتادة في مدينتنا، لكن العكس هو ما حدث. ففي اليوم الثاني، حضر شخص يقاربه في السن، غريب السحنة، ولهجته تميل إلى لهجة سكان وسط سوريا. جلس قبالتنا معزّياً، ثم قال جملةً: "كان فدائياً بكل معنى الكلمة... الله يرحمه"، ما أعاد طرح الأسئلة في رأسي. وبحدس صحافي، قمت من مكاني بعد برهةٍ من الوقت لأجاور الرجل، وأطلب منه أن يرافقني إلى خارج خيمة العزاء، وعلى طرفي طاولة صغيرة تشبه طاولات التحقيق، جلسنا متقابلَين ليسرد لي تفاصيل الحكاية من أولها، فعرفت أن "ماري"، بقيت مسيحيةً كشرط منها للزواج بأبي، لكنها حرّفت اسمها ليصبح مريم، أو "مريومة"، كما كان يدّلعها ذاك المشاكس المربوع القامة، وأن رفاقه كانوا ينادونه بلقب "أبو عرب"، بدلاً من "أبو يعرب".
مرت سنوات، وأنا أعدّ أن حكايته نموذج للعنة الدم التي يعيشها العشاق في سوريا خصوصاً، وفي الدول العربية التي تحوي تنوعاً عرقياً، أو دينياً، فهي مجتمعات تميل نحو جعل الدين وموروثه أساساً للقواعد المجتمعية، إلى درجة كنت أرى فيها أن من القضايا التي يجب أن أجاهد لنصرتها، هي أي حكاية عشق تجمع بطلين قررا الوقوف في وجه المجتمع، ليكسرا الأعراف القبلية والطائفية التي لبست لبوساً دينياً حتى بين أبناء الدين الواحد، لاختلافهما مذهبياً فحسب، لكني كنت حذراً من الوقوع في هذا الفخ، حتى أحببت "درزيةً"، بهذه البساطة، ومن دون مقدمات، وبت أرسم خططاً لنؤسس لحراك مدني انطلاقاً من العشق، ونصرته. وقد حسبت أول الأمر أن قوننة الزواج المدني في سوريا ستكون كفيلةً بإنهاء سحر "لعنة الدم"، التي ورثناها جيلاً بعد جيل، وحسبي في ذلك أن عشقي سينجو من مصيره المحتوم إن قدرت ومناصري قانون الزواج المدني، من الوصول إلى إقراره. لكن ثمة ما وأد ذاك العشق سريعاً، ومع ذلك بقيت الأسئلة تراودني عن سكوني، فتخليت عنه.
دفع الحب أبي للهرب بحبيبته الأرمنية إلى لبنان، وهناك بقي مقاتلاً في صفوف إحدى الفصائل الفلسطينية إلى أن توفيت "ماري"، وابنهما "يعرب"، في قصف إسرائيلي على قرية في جنوب لبنان
في إحدى النقاشات الذاتية حول القضية، كان لا بد لي من أن أكتب على الورق ما هو أصل المشكلة التي عاشها أبي، وعشتها من بعده، وهو ببساطة الموروث المجتمعي القائم على جعل القتل، رد الفعل الأبسط لإنهاء أي حكاية عشق تحاول التمرد. والقضية لا تقف عند الزواج المدني وقوننته، إذ إن إحدى المنظّرات والداعيات لإقرار قانون الزواج المدني بدفعٍ من نسوية تزعمها، كانت قد حبست ابنتها ثلاثة أشهر في المنزل، بعد اكتشافها أن عشقاً محرّماً يجمعها بشاب مختلف دينياً، وقد شكّل هذا الحدث صدمةً ذاتيةً بالنسبة إلي، إذ كيف أريد مجتمعاً مدنياً، وثمة كذابون يتسلّقون الفكر المدني ليقدموا أنفسهم للمجتمع بشخصيات مناقضة لواقعهم، وكيف سأصدّق مثلاً أن شيخاً يدخل كنيسةً في مناسبة سياسية، أو قديساً يتحدث عن أخوّة الهلال والصليب، سيمتنعان عن تزويجي بمن أحب إن كانت مختلفةً عني دينياً، بل وسيعدّان هذا العشق كفراً مباحاً!
ثم كيف لقوانين دولة ترى أنه من الإلزامي في مكان، حصول الدرزي على ورقة "تبديل مذهب"، إذا ما أراد أن يتزوج بامرأة ليست درزيةً، وأن المسيحي ملزم بإعلان إسلامه، إن عشق مسلمةً، وهاتان مسألتان شهدت على حدوثهما لأشخاص أعرفهم، ومنهم أصدقائي، وتالياً فإن القوانين وأحاديث الشخصيات الدينية عن التسامح وقبول الآخر، ما هي إلا دجل صريح، يغلَّف بجملٍ منمّقة تُحكى أمام الكاميرات، أو على المنصات الرسمية، وعند أول حالة عشق تتمرد على كل القواعد المعمول بها مجتمعياً، ويختفي التسامح، ويكون الأشخاص أنفسهم حاضرين لأن قيم المجتمع والحفاظ على الترابط وتجنب الصدامات بين العائلات هي الأولوية على حالة عشق سيصنّفونها تحت مسمى "نزوة عابرة"، أو "طيش مراهقين".
مجتمعاتنا تميل نحو جعل الدين وموروثه أساساً للقواعد المجتمعية، إلى درجة كنت أرى فيها أن من القضايا التي يجب أن أجاهد لنصرتها، هي أي حكاية عشق تجمع بطلين قررا الوقوف في وجه المجتمع
كيف لقوننة الزواج المدني أن تنهي المشكلة، إن كان المجتمع لا يقبل أن يفسح للمدنية مكاناً، ولن يكون التغيير سهلاً إن كان من بين المنظرين للمدنية من يرون أن المطالبة بالتغيير جائزة، ما لم تمسهم بشكل مباشر، كأن يدعو الشخص سين للزواج المدني، لكنه في الوقت ذاته لن يقبل بأن تكون ابنته زوجةً لشخص من مذهب أو طائفة أو دين مختلف، ووجود أشخاص مزدوجي المعايير بين منظري المدنية، يُعد واحداً من أهم أسباب فشل الوصول إلى مدنية كاملة، كما أن عدم وجود قوانين تفرض عقوبات غليظة على رجال الدين في حال ممارستهم أي نوع من خطاب الكراهية تجاه الآخر، بحجة الحفاظ على السلم الأهلي، بحفظ الموروث والأعراف الشعبية، يُعد سبباً أساسياً في بقاء المدنية متعثرة البدايات، فرجال الدين يستمدّون سلطتهم من تغذية الكراهية والشقاق الإنساني، بتوظيف النصوص المقدسة بما يجعل من هذه السلطة مستدامةً، فماذا لو أن الشيخ الذي لجأ إليه أبي ليكون "وسيط خير"، يقنع جدي بصلاح زواجه من "ماري"، لم يطرده من حضرته بحجة أن عليه حق السمع والطاعة لأبيه الذي يقدر له الأفضل، كونه لم يكبر بما يكفي ليقرر من هي الزوجة الصالحة له. ثم ماذا لو أن رجال الدين آنذاك أجبروا سكان الحي على الكف عن عدّ "مريومة"، "عايبة ومسيئة إلى الدين قبل أن تسيء إلى أهلها"؟ هل كانت أسرتها ستغادر المدينة نحو أوروبا، من دون أن تعرف حتى اليوم أن "ماري" توفيت، وهي مسيحية؟ وماذا لو أن الدم الذي نرثه رغماً عنا لا يكون لعنةً تقتل العشق حين يصطدم بحواجز القبيلة والدين؟ هل كانت تلك المنظرة للزواج المدني ستسجن ابنتها لثلاثة أشهر لأنها أحبّت فحسب؟ هل كنا سنسمع بكل جرائم القتل التي تُسمّى زوراً "جرائم باسم الشرف"؟
على سلطويي الدين أن يعوا أننا مدنيون، لكننا لسنا كفاراً.
لو أن حراكاً مدنياً يولد بشكل علمي، يبدأ من نقطة صفر هي محاولة إقناع رجال الدين بخلق خطاب متوازن لا يقصي الآخر، ولا يكفّره بما يجعل الحديث عن تآخي الهلال والصليب حديثاً علمياً ومنهجياً ومعمولاً به بشكل حقيقي في دور التعبّد، وألا تكون تغذية الكراهية أساساً لاستمرارية السطوة الدينية لرجال المعابد على أبناء المجتمعات، ربما سيكون ثمة مجتمع مدني، ولو بعد سنوات طويلة. مجتمع يحتاج فعلاً إلى قوانين مدنية سيعمل بها، لا أن تكون "بريستيجاً" قانونياً، ومحض حبر رخيص على ورق أرخص، ولن تكون ثمة مدنية في مجتمعاتنا إن كان خطاب المنظمات متعددة الأنشطة في هذا المجال، موجهاً إلى شريحة الشباب فحسب، بحكم أن تغييرهم أساس لنجاح مشاريع هذه المنظمات، وذلك لأن معالجة جذر المشكلة هو المطلوب، لا تقليم الفروع التي يمكن لها أن تنمو مجدداً.
إن تمت معالجة الكراهية، وقُلّمت أظافر رجال المعابد، وبُنيت الأسس الصحيحة للمدنية، ربما سنصل يوماً إلى مدنية كاملة في مجتمعاتنا العربية، وربما حينها سيكون سهلاً أن تعود والدة "ماري"، بكل شجاعة، لتبحث عن ابنتها، وستقرأ لها صلاةً حين تزور قبرها المنسيّ في تلك المدينة القصيّة. فعلى سلطويي الدين أن يعوا أننا مدنيون، لكننا لسنا كفاراً.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.



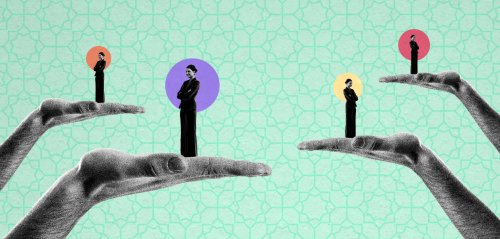


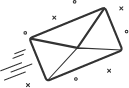
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 22 ساعةجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ يومينمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ يومينفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ يوميناهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار