في ظل صراع الكتاب الورقي للبقاء في عالمنا المعاصر الذي تغزوه التكنولوجيا، يبدو إغلاق مكتبة ما أبوابها، في أي بلد في العالم، أمراً غير مفاجئ. إلا أن حدثاً كهذا في سوريا، على الرغم من عدم فرادته في السنوات الأخيرة، يأخذ بُعداً عاطفياً ودرامياً هائلاً. هذا ما حصل بالفعل عندما أعلنت مكتبة نوبل في دمشق، أنها ستغلق أبوابها بشكل نهائي. تداول بعض الأصدقاء الخبر على منصات التواصل الاجتماعي بالكثير من الأسى والحزن، وكأنه أشد الأحداث مرارةً، والمؤشر الأبرز على قتامة مستقبل البلد.
أن تخسر دمشق وجهها الثقافي، وتسقط أوراق مكتباتها الواحدة تلو الأخرى، تلك المكتبات التي كانت تغذّي عقولنا على مدار سنوات طويلة، وتجعل من دمشق ما هي عليه، لا يهم في الواقع إلا قلة فقط، وهذا كحال التردي الثقافي عموماً، وانهيار الفنون بالمجمل، كالسينما، والمسرح، والدراما، على العكس تماماً من تدهور الأحوال الاقتصادية التي تشكل هاجساً وتهديداً للجميع، وهذا مفهوم ومشروع بكل تأكيد.
في وجه الجوع لا يصمد شيء، ولا شيء يبدو ذا قيمة في نظر الكثيرين، مقارنةً بهذه الحقيقة.
في وجه الجوع لا يصمد شيء، ولا شيء يبدو ذا قيمة في نظر الكثيرين، مقارنةً بهذه الحقيقة. كنّا نعي خلال سنوات طويلة، أن الفقر في بلادنا مُمنهَجٌ، وله أهدافه، حتى ننشغل بلقمة العيش عن أي أحلام وأمنيات أخرى، فالجائع يسعى إلى ما يُسكت جوعه فحسب. مع هذا، كنّا نقاوم. لكن اليوم ينهار كل شيء، وتنتصر المطاعم التي تملأ المدينة، والتي يبدو أنها تقاوم الجوع، ولكنها في الحقيقة سببه، إذ إن معظمها ليس أكثر من واجهات لتبييض أموال تجار الحرب.
أفكر في طفولتي، وسنوات مراهقتي، عندما اكتشفت عالم الكتاب وقيمته، وبدأت معاناتي للحصول عليه، خاصةً أنه لم توجد في بيتنا مكتبة. ولا يمكن تخيّل مقدار صعوبة هذه المهمة، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يسكنون القرى أو البلدات في شمال شرقي سوريا. كان عليّ بعد ادّخار المال، أن أجد مكاناً يبيع نوع الكتب التي أفضّلها. والحقيقة أن الأمر لم يكن سهلاً. ترددت كثيراً إلى المحال التي تبيع القرطاسية، والتي يملك بعضها رفاً صغيراً يحتوي على بعض الكتب، روايات أحلام مستغانمي، وبعض مؤلفات نزار قباني الشعرية، وروايات عبير، فحسب. لا شك أنني استهلكتها في البداية، بشغف شديد، لكن حان الوقت الذي انتهيت فيه منها، وبدأت أتوق إلى الجديد.
مدرستي في المرحلة الإعدادية لم تكن تحتوي على مكتبة، ولا حتى على كتاب واحد خارج المنهاج المدرسي، فاقتصرت مطالعتي في هذه الفترة، على الكتب التي كنت أستعيرها من أحد أقاربي. وكم كنت أدعو الله أن ينسى مطالبتي بالكتب التي استعرتها منه، وقد حدث ذلك بالفعل حين احتفظت برواية "مئة عام من العزلة"، لغابرييل ماركيز، ولم يلاحظ. قرأت هذا الكتاب بشكل متقطع على مدى سنوات، ربما رغبةً مني في اختبار تجربة امتلاك كتاب لست مضطرةً إلى إعادته بعد أيام.
لكن اليوم ينهار كل شيء، وتنتصر المطاعم التي تملأ المدينة، والتي يبدو أنها تقاوم الجوع، ولكنها في الحقيقة سببه، إذ إن معظمها ليس أكثر من واجهات لتبييض أموال تجار الحرب
لسوء الحظ، كانت مدرستي الثانوية حديثة العهد. فبسبب قرار مفاجئ بفصل الإناث عن الذكور في المرحلة الثانوية في بلدتنا، احتفظ الشباب بالمدرسة القديمة، وانتقلنا، نحن الفتيات، إلى المدرسة الجديدة، والتي لم تكن تمتلك مكتبةً بعد. كان علينا أن نُنشئ مكتبتنا بأنفسنا، فأُلزمت كل منا بالمساهمة بكتاب ما. هكذا خسرت ديوان نزار قباني "طفولة نهد".
كنت أقف أمام رفوف المكتبة الناشئة مندهشةً من بعض التصنيفات التي لا أفهمها، ومن رداءة بعض الكتب، ومن تكرار بعضها الآخر. مع ذلك، أمضيت ثلاث سنوات أتردد عليها، حتى حصلت على امتياز استعارة أكثر من كتاب في وقت واحد، بعد أن نشأت علاقة ثقة بيني وبين أمينة المكتبة.
لن تصبح يوماً الأزمة أزمةً بالفعل، حتى تصل إلى دمشق.
عندما انتقلت إلى الدراسة في دمشق، قضيت ساعاتٍ أسير من كلية الآداب، إلى كلية الحقوق، وأنا أتصفّح الكتب المعروضة على امتداد الأرصفة. رددت في نفسي بذهول: "يا الله الكتب بتنباع هون عالرصيف!"، كان عليّ أن أواجه للمرة الأولى، كماً كبيراً من الكتب، ومبلغاً ضئيلاً من المال، وأن أتّخذ قراراً شجاعاً في الاختيار. الكتب خارج دمشق لم تكن خياراً صعباً. في الواقع، لم تكن خياراً من الأساس.
في ألمانيا، وبعد أن قضيت سنتي الأولى في قريةٍ صغيرة، لم أجد شيئاً يمكن للألماني الحصول عليه في المدينة، ولا يمكنه الحصول عليه في الريف. المنتجات والخدمات والإمكانيات ذاتها في كل مكان، بل إنّ الحياة في الريف، هي خيارٌ محبَّبٌ للكثيرين من أولئك الذين يفضّلون الهرب من صخب المدينة. حتى أن معظم الألمان لا يتوقون إلى الحياة في برلين، ويتذمّرون من أنها مزيج ثقافات، ولا تعبّر عن الحياة والثقافة الألمانيتين، الأمر الذي أثار استغرابي في البداية؛ إذ كيف لا يُفضّل الألماني برلين، بينما نتسابق نحن العرب، وخصوصاً "المثقفين منّا"، للعيش فيها؟ بدا من الواضح أننا حملنا ولهنا بالعواصم، هذه السمة العربية، التي ساهمت أنظمة الحكم في بلادنا في ترسيخها، عبر إهمالها لكل ما عداها.
شكّلت دمشق بالنسبة إلينا، الوجهة والحلم، ولا يخفّ وهجها إلا حين تنافسها حلب، ونتنافس نحن في الوصول إليها، لنحظى بامتيازاتها أخيراً، في حين يعيش معظم السوريين خارجها على هامش الحياة، والحسابات السياسية والاقتصادية والثقافية.
حتى أن معظم الألمان لا يتوقون إلى الحياة في برلين، ويتذمّرون من أنها مزيج ثقافات، ولا تعبّر عن الحياة والثقافة الألمانيتين، الأمر الذي أثار استغرابي في البداية؛ إذ كيف لا يُفضّل الألماني برلين، بينما نتسابق نحن العرب، وخصوصاً "المثقفين منّا"، للعيش فيها؟
طوال سنوات الحرب السورية، والميزان الذي تُقيَّم وفقه الأزمات، يثير الدهشة. لن تصبح يوماً الأزمة أزمةً بالفعل، حتى تصل إلى دمشق. كل ما تعانيه الأرياف أو المدن التي ينظر إليها وكأنها أرياف، لا يُشكل مشكلة حقيقية من وجهة نظر أولئك الذين يُقيّمون سوء الأحوال، ويطالبون باتخاذ تدابير ضدها، سواء أكانوا سياسيين، أو إعلاميين، أو مثقفين، أو حتى فنانين. الأزمات تبدأ فقط عندما تحدث في دمشق. فالذي يبدأ بتفاوت الخدمات، كتوفر الكتاب، أو انعدامه، مثالاً، ينتهي بتفاوت أهمية الأرض، والأرواح، والكيانات.
إن كانت بعض الجغرافيا السورية أهم من بعضها الآخر، وإن كان ما يحظى به بعض مواطنيها، يحتاج بعضهم الآخر إلى زمن طويل ليحصلوا عليه، فلماذا ننكر ونستنكر ما آل إليه الوضع في البلد، وانقسام الأرض على هذا الشكل الذي هي عليه اليوم؟ أليس من الأجدى أن نتساءل ما إن كُنا قد حيينا يوماً في سوريا واحدة؟ هل كانت سوريا حقاً واحدة فقط، ولم تكن مجزّأةً بالفعل؟ ألم تكن سوريا منذ وقت طويل مقامات؟ وهل ما زال من الممكن إنقاذ دمشق أول امتياز، وآخر امتياز لنا، في بلدٍ حلمنا بولادته طويلاً، فأودينا به، وأودى بنا إلى المقبرة؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






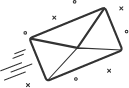
انضم/ي إلى المناقشة
Tester WhiteBeard -
منذ 4 ساعاتEgypt
Tester WhiteBeard -
منذ 4 ساعاتGreat
Ayar Abdelkreem -
منذ 22 ساعةكانت مكتوبة مقال رأي وتم رفضه من رئيسة التحرير،
Ayar Abdelkreem -
منذ 22 ساعةكانت فكرتي
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ يومأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ يوماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار