لا تنتهي اختبارات الأمومة أبداً. كنتُ أضحك من جملة أمي المُكررة: "بكبروا وبكبر همهم"، وأشاكسها بأنها هي التي تحمل هموم الكون فوق رأسها. وكنت أردد بكل زهو واقتناع: "ليس صحيحاً تماماً يا أمي، ربّيتُ ابنتيّ على أساس أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة، وهذا يسهّل عليّ كثيراً، وعليهم. الحياة ستمضي بهم ومعهم، وأنا أتفهم هذا، وأتأقلم معه".
لا زلت أذكر نظرة أمي في تلك اللحظة، والابتسامة الساخرة التي رمتني بها، وكررّت بيني وبين نفسي للمرة الألف: "كم أنتنّ من جيل صعب ومركّب... كم تهوّلين الأمور يا أمي، لن أكون مثلك بالتأكيد".
في الصيف الماضي، سافرت ابنتي الكبرى لاستكمال دراستها الجامعية. كان كل شيء مرتباً ومنظماً بطريقة تبعث على الارتياح والطمأنينة، فبنتُ رحمي التي كبرت تحت شعار "أولادكم ليسوا لكم"، تعرف ماذا تريد، وتتّخذ قراراتها بشكل مستقل، وتشارك مشاعرها بأسلوب جميل ومنفتح، تحديداً معي أنا أمها. مشى كل شيء بالشكل المثالي الذي لا غبار عليه؛ أنا أثق بها، وبقراراتها، واعتمد عليها، وهي الآن تفتح جناحيها، وتستعد لرحلة الطيران الأولى، وفق النظرية الجبرانية السحرية.
نظرت إلى ابنتي تقف على الرصيف وحيدةً. منذ الآن سأمضي وتمضي. بكت وبكيت. ركبت في التاكسي باتجاه المطار، ومن يومها لم يعد أي شيء في حياتي يسير كما كان. تعطّل كل شيء؛ جسدي، وعقلي، وأفكاري، وتركيزي. عالمي كله تعرّض لزلزال ما زلت أعيش توابعه حتى الآن
نظرت إليها تقف على الرصيف وحيدةً. منذ الآن سأمضي وتمضي. بكت وبكيت. ركبت في التاكسي باتجاه المطار، ومن يومها لم يعد أي شيء في حياتي يسير كما كان. تعطّل كل شيء؛ جسدي، وعقلي، وأفكاري، وتركيزي. عالمي كله تعرّض لزلزال ما زلت أعيش توابعه حتى الآن.
لم يعد النوم سهلاً، ولم يتوقف شلال الدموع، سواء أكانت مرئية أم لا. صور الماضي وروائحه تعود قويةً ومكثفة. طفولة ناي، وأمومتي الأولى، وتخبّطي في الطريق الوعر بلا علامات عليه، إذ طريق الأمومة وعر ومضلّل مهما بدا واضحاً وميسّراً. ما رغبت فيه كله، هو أن أمسك جبران من رقبته، وأصرخ فيه بقوّتي كلها: "لا تتحدث باسمي من الآن وصاعداً. فابنتي هي ابنتي، ويكفيك تنظيراً".
بلغ غضبي من جبران درجةً تنكّرتُ معها لسنوات قراءتي الأولى له، ونعتتُ نفسي بالساذجة، ورأيته متحذلقاً، وتساءلت كثيراً: كيف أمكن لرجل أن ينظّر علينا نحن النساء بالذات، بأن أبناءنا الذي خرجوا من أرحامنا ليسوا لنا؟ لا يملك الرجال أرحاماً تصلهم جسدياً وروحانياً بهذه الكائنات التي تكبر يوماً بعد يوم في جسدهم. فكيف يقول جبران ما يقول؟
كيف أمكن لرجل أن ينظّر علينا نحن النساء بالذات، بأن أبناءنا الذي خرجوا من أرحامنا ليسوا لنا؟
ولكن، كيف انطلت عليّ أنا هذه المقولة المرعبة: أولادكِ ليسوا لك، ولا علاقة لرحمك، ولبقية التفاصيل التي عشتها وصولاً إلى ملحمة الولادة، وزلزال الاكتئاب والرضاعة، والتفاصيل الأخرى كلها التي شكّلت حياتين متوازيتين لأم وابنتها، من اللعب، والضحك، وتهاليل ما قبل النوم، والرعب من شق السن الأول للثّة الفم الصغير، إلى رائحة النوم، وانصهار جسديكما معاً في حرارة واحدة، إلى الرقص، والفساتين، والدموع، والماء، والتراب، وما عشناه معاً كله، أنا وأنتِ؟ هذا كله لا شيء، مقابل أن أكون أمّاً عاقلةً وحكيمةً تعرف أن خيط الأولاد لا بدّ أن يُفلت، وأن نتركهم يحلّقون.
الانفصال الوحيد الذي تقبله الأمهات برضا وعقلانية، هو قطع الحبل السرّي عن أولادهنّ، وعدا هذا طاقة الجذب هي المسيطرة على العلاقة مع الأبناء، وأعي تماماً أنها تكون مرضية أحياناً، وإن تسلحت بمعاني الحب، والقرب، والحماية، والرعاية.
هل كتب جبران هذا بتأثير من حياته في المهجر، حيث يعيش الناس في كيانات فردية لا يفضلون فيها النظر طويلاً في علاقتهم بالأم، والأب، والأخوة، والعائلة عموماً؟ قلعة الفردانية التي لا يصلها أحد، ولا يقترب منها أحد؟ أم أنه كان يغطّي ويتكابر على ألمه، وغربته، وابتعاده عن حضن أمه وعائلته؟ ربما أقنع نفسه بأن درب الحياة السويّة، هو هذا الدرب، والأفضل أن نسير عليه باختيارنا ووعينا؟
تم تخريب شيء ما في روحي وعقلي حول الأمومة، وهو خليط من تجارب أمي، وجيلها الذي رفضتُ أن أكون مثله، وأن أكرّره. وفي المقابل، كانت الحياة الجديدة ترسم بعناية خط جيلي من النساء الذي لا بدّ أن يتعلم، ويعمل، ويقلل من دور الإنجاب، لأنه علامة على التأخّر والقبول بدور أقل في الحياة. ولكنه في الوقت نفسه لم يتوقف عند أسئلة الإنجاب كسؤال شخصي، هل كنت أرغب به أم لا؟ لم نصل إلى تلك المرحلة من طرح الأسئلة المحظورة، والتمرد، والثورة، هذا على اعتبار أننا بدأناها فعلاً كجيل.
هل نملك اليوم نحن النساء، روايتنا ومقولاتنا حول الأمومة؟ وهل نجرؤ أن نجهر بها؟ هل نقول مثلاً دفعت ثمن إنجابك من جسدي، وخلايا أعصابي، ودمي، لذا أنتظر منك أن تعوضيني عن هذا كله، ليس لأنها مقايضة حسابية، بل لأنها حاجة روحية ونفسية؟
الانفصال الوحيد الذي تقبله الأمهات برضا وعقلانية، هو قطع الحبل السرّي عن أولادهنّ، وعدا هذا طاقة الجذب هي المسيطرة على العلاقة مع الأبناء، وأعي تماماً أنها تكون مرضية أحياناً، وإن تسلحت بمعاني الحب، والقرب، والحماية، والرعاية
أو أن أقول: لم يسألني أحد حول ما إذا كنتُ أريد حقاً أن أكون أمّاً، لذا كان هذا قدري أن أنجبكِ، فتحمّلي كما تحمّلت؟ مرة أخرى، في حالتي على الأقل كأم لابنتين، أحملهما وأحمل معهما إرثنا الثقيل في الاختيار، ودفع الأثمان؟
هل ستقول أي منا، إن الأولاد تعويض عن خيبات القلب، والهجران، والخذلان، وخراب الجسد، ووجع الوطن، والغربة؟ وإننا نتوقع أن يعيد الأبناء ترميم هذا الخراب لأجلنا؟
هل تقول إحدى النساء: لم أنفصل عن والدكم، لأنني افتقدت الشجاعة، ولم أكن أريد الطلاق أصلاً، ولهذا أريدكم معي، وإلى جانبي، لأنني أخاف من الانفصال، والابتعاد، والوحدة؟
وبعد هذا كله، وقبله، بماذا اختلفنا إذاً عن أمهاتنا اللواتي لطالما تمسّكن بنا بالأظافر، والأيدي، والأسنان، وبكين حتى لا نبتعد؟
وبعد هذا كله، وقبله، بماذا اختلفنا إذاً عن أمهاتنا اللواتي لطالما تمسّكن بنا بالأظافر، والأيدي، والأسنان، وبكين حتى لا نبتعد؟ أين حدود الأنانية هنا، والتملك؟ وأين المحبة التي تُتَرجَم بأبسط معانيها، بقرب الحبيب، ولكن من دون مسحه وتغييب رغباته؟
وهل يجوز في معايير الحياة المعاصرة، حيث جاهدَت كل منّا لتحصّل تعليماً عالياً، ومهنةً تنافس بها عدداً لا بأس به من الزملاء، وتمرّدنا على أدوار أمهاتنا وجدّاتنا التقليدية، واقتنعنا بأننا متمرداتٌ، وثائراتٌ، ومجدداتٌ، وبأن أولادنا تحديداً ليسوا لنا، لأننا حكيماتٌ، ونلعب لعبة الانفصال الصحّي المزعوم؟ كيف نعود فجأة إلى دور الأمومة الأقل تقديراً، والأقل اعترافاً، ونستسلم لنقول: أنتم أجمل ما صنعنا يا أولاد، ولا تبتعدوا كثيراً، وابقوا إلى جانبنا؟ كم ستبدو الجملة مهينةً، وصعبةً، على من تمرّدن على قواعد البيت، والبقاء فيه، أو في ساحاته؟ من تجرؤ على الكلام؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






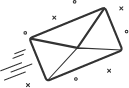
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ 3 أياممدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أياماهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار