واحدة من أكثر الجمل تداولاً، في النقاشات السياسية والاجتماعية في العالم العربي، هي جملة "نحن شعوب عاطفية"، و"دمنا حامي". جملٌ توضح صفاتٍ وسماتٍ شخصية لسكان هذه المنطقة، تماماً كما يصف الكثيرون الشعب الإنكليزي، على سبيل المثال، بـ"البارد".
الكثيرون من أصحاب "الدم الحامي"، يتعاملون مع الأمور بمبدأ العاطفة، مهما يكن هذا الأمر، سواء أكان سياسياً، أو عاطفياً، أو عائلياً. كذلك الأمر بالنسبة إلى ما يتعلق بالأوطان، إذ يغيب العقل أمام العاطفة، وكذلك أي أسباب منطقية، أو موضوعية للتعاطف، أصلاً، وكأن الأمر ما زال يسير بالمنطق القبلي السائد، منذ أكثر من ألف عام.
يتمثل هذا الأمر بالحماسة الشديدة للأغاني الوطنية مثلاً، وهي الأغاني التي تتغنّى بالبطولة، والقوة، والأمجاد الغابرة، بموسيقى حماسية تجعل من يسمعها متأهباً للحصول على سلاح "آر بي جي"، والتوجّه صوب القدس، أو الجولان، مع اغريراق عينيه بالدموع، وينهيها بتنهيدةٍ، لإخراج ما به من ضيق.
شهد جيلي ظهور أغانٍ وطنية متتالية، ليس أولها "أنا سوري آه يا نيالي"، ولا آخرها "طير الحرية"، وأغاني الثورة السورية، وغيرها. لكن، وهنا لبّ الموضوع، ماذا قدم لي الوطن، سوى تلك الأغاني؟
لكيلا يذهب الأمر إلى مسار لا أريده، أنا لست ضد الأغاني، ولا التغني بالأوطان. ولكن بنظرة بسيطة للغاية، فإن العاطفة إذا نظرنا إليها من منظار واقعي، وبتجرد، هي فعلياً علاقة مصلحة متبادلة بين طرفين، كما العلاقات الأخرى كلها، التجارية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية أيضاً، لكن الفارق هنا، هو أن العلاقات العاطفية مع الحبيبة، أو الأهل، تملك تفاصيل أكثر تعقيداً، وأوسع مساحةً، ما يمنح البشر القدرة على التعامل معها بشكل مختلف، وإكسابها صفة القداسة، وتالياً من السهل تأليف أغانٍ، وصناعة أعمال فنية، تعزز هذه الأفكار، وقدسية هذه العلاقات، بما فيها العلاقة بين الفرد وبلده.
يعرف أبناء جيلي، والأجيال السابقة، هذه المشاعر، ربما أكثر من الأجيال الجديدة، إذ شهد جيلي ظهور أغانٍ وطنية متتالية، ليس أولها "أنا سوري آه يا نيالي"، ولا آخرها "طير الحرية"، وأغاني الثورة السورية، وغيرها. لكن، وهنا لبّ الموضوع، ماذا قدم لي الوطن، سوى تلك الأغاني؟
دعونا نتوقف مثلاً عند أغنية "أنا سوري آه يا نيالي"، التي قدّمها الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي في التسعينيات من القرن الماضي، وتتحدث عن طرد السوريين للمحتل الفرنسي، ونضالات السوريين في تلك الفترة. أمر جميل أن نذكر التاريخ، ونعرفه، وننقده، ونستفيد من دروسه للمستقبل، ونذكر تضحيات الأجداد. ولكن في المقابل، هل يرتاح أجدادنا في ترابهم، وهم يسمعون أصوات البراميل التي تهبط على قبورهم؟ أو وهم يرون أحفادهم بين معتقلٍ، وشهيد، ومغيّب، ولاجئ؟ الأمرّ من هذا كله، أن الأغنية نفسها لا تتحدث عن السوريين وحدهم، بل تمتد كلماتها للتأكيد على فداء "الأمة العربية بالروح والمال"، وكأن لا أكراداً، ولا سريان، ولا آشوريين، ولا أمازيغ، حتى في هذا الوطن! هم ليسوا موجودين أصلاً، ولا حقوق لهم، حتى يُذكروا في عمل وطني. المشكلة أن الأغنية جاءت بعد خيبات سياسية وعسكرية، والجولان محتل من دون أي قدرة على تحريره، وفلسطين ضائعة، وجامعة عربية وجودها كعدمه، ولا مشاريع ولا تكاملاً اقتصادياً، ولا تأثيراً عالمياً لبقعة من أغنى بقاع الأرض.
أسأل كما السوريين كلهم، اليوم، على اختلاف مواقفهم السياسية والإنسانية مما حصل، ويحصل، وسيحصل، في سوريا، لماذا سيبقون في بلاد لا تحبهم؟
في الأيام الأخيرة، خرج رئيس غرفة تجارة حلب، فارس شهابي، ابن رئيس أركان الجيش السوري الأسبق في عهد حافظ الأسد، حكمت الشهابي (يُقال إنه كان ضد استلام بشار الأسد حكم سوريا). المهم، أشار الشهابي الابن إلى هجرة الصناعيين السوريين من البلاد، محذّراً من خطورة هذا الأمر على مستقبل الصناعة السورية. لكنني أسأل كما السوريين كلهم، اليوم، على اختلاف مواقفهم السياسية والإنسانية مما حصل، ويحصل، وسيحصل، في سوريا، لماذا سيبقون في بلاد لا تحبهم؟ آلاف الشباب يهاجرون اليوم من سوريا، إلى أربيل، ومصر، ودبي، هجرة لا تشبه الهجرة إلى أوروبا كثيراً، لكن من يغادر، يعرف أنه لن يعود إلا إن أحب أن يموت في بلده، أو يُدفن فيها، لا أكثر!
السؤال يجب أن يكون بصيغة النفي الاستنكاري: "لماذا لا يهاجر السوريون"؟ ماذا بقي لهم من سوريا؟ وماذا قدمت لهم أصلاً، سوى ذكريات مغلفة بأوراق العاطفة المقدسة؟ من سيبقى تحت رحمة ارتفاع غير مسبوق للدولار، أمام الليرة السورية، وتقنين كهربائي لساعات طويلة، وطوابير الخبز، والغاز، في مشاهد تذكّرنا بأيام سفر برلك، الورقة التي استخدمها النظام السوري طويلاً، للنيل من تركيا، في أثناء الخلافات في التسعينيات، أو بعد عام 2011.
لماذا لا يهاجر السوري، ويرحل؟ لماذا سيبقى في بلد لا يستطيع فيه أن يرفع رأسه، لينتقد أوضاعاً معيشية بائسة، في زمن الفاجعة؟ حتى الموالون للنظام السوري، ممن يمجّدون بطولات جيشه، لا يمكن لهم الانتقاد، وإلا فمصيرهم معروف، وهنا لا أبالغ في الوصف، فقد حدث فعلاً.
يقال إن الوطن هو المكان الذي لا يفكر الإنسان بالهرب منه. يا للسخرية إذاً. هناك ملايين من السوريين المقيمين على أرضهم، بلا وطن، على اختلاف توزعهم على مناطق السيطرة المختلفة، وبعد أن فقدوا الخدمات كلها التي من المفترض أن يقدمها لهم هذا الوطن، من رفاهية، ومعيشة جيدة، وتقدّم علمي، وسيادة، وقانون، واحترام للمرأة والطفل، واقتصاد قوي، وحقوق الإنسان، وديمقراطية، وأحلام، ونقد، ونقد مضاد. لم تبقَ لهم سوى العاطفة، مذ سُلبت منهم هذه العناصر، قبل خمسين عاماً، واليوم تُسلب العاطفة والذكريات من بين أيديهم، وتسقط في زمن الهجرة، ويدوسها المواطنون بأقدامهم، في سبيل الحياة!
ملايين السوريين الذين لم يختاروا القدوم إلى هذه الحياة أصلاً، وجدوا أنفسهم في بلاد بائسة، بلاد متناقضة، غنية لكنها فقيرة، وقوية لكنها ضعيفة... هؤلاء السوريون (وأكاد أجزم أن الأمر ينطبق على العديد من البلاد العربية، وغير العربية أيضاً) لا يملكون ماضيهم الذي زُوِّر منذ قرون، ولا حاضرهم الذي يتحكم فيه الديكتاتور، ولا مستقبلهم المرهون بتوافق الدول الإقليمية، والدول الكبرى.
ليغادر السوريون جميعاً، وليجدوا أوطاناً بديلة، ولو لفترات مؤقتة، ودعوا هذه المدن لمن هدد يوماً بإحراق البلاد، وإحراقنا نحن، ليتجول فيها وحده، ويقف على طوابير الغاز، والخبز، وحده، ويمارس ديكتاتوريته على نفسه، ولنحوّل نحن، سوريا، إلى متحف كبير في ذاكرتنا
إذا لم يملك السوري ما ذُكر كله، وخسر الورقة الأخيرة، وهي العاطفة، حينها تتحول الهجرة إلى فرض حياة واجب تجاه النفس البشرية، لإعادة صياغة الذات، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه منها. هنا لا مفرّ من تدمير مفهوم الانتماء في أعماق الإنسان، للحصول على حد أدنى من الأمل الصالح، للتعامل مع ما تبقى من أعمارنا، نحن البؤساء، بأقل قدر من الخسائر.
إذاً، ليغادر السوريون جميعاً، وليجدوا أوطاناً بديلة، ولو لفترات مؤقتة، ودعوا هذه المدن لمن هدد يوماً بإحراق البلاد، وإحراقنا نحن، ليتجول فيها وحده، ويقف على طوابير الغاز، والخبز، وحده، ويمارس ديكتاتوريته على نفسه، ولنحوّل نحن، سوريا، إلى متحف كبير في ذاكرتنا، نحكي عنه لأجيال مقبلة، عسى ألا تخطئ في الانغماس في عاطفة لا تساوي شيئاً في زمن الهجرة.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






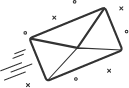
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ 20 ساعةتعليقا على ماذكره بالمنشور فإن لدولة الإمارات وأذكر منها دبي بالتحديد لديها منظومة أحترام كبار...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامUn message privé pour l'écrivain svp débloquer moi sur Facebook
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ 3 أيامأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ 4 أيام❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 6 أيامجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...