 مجاز القناع الذي خلف وجهي
مجاز القناع الذي خلف وجهي
سألني ابني عن أول فيلم شاهدته في حياتي، أعادني سؤاله بالزمن عشرين عاماً إلى الوراء، طفت الذكرى على السطح جالبة معها مزيجاً من النشوة والبهجة، كان فيلم "دعاء الكروان"، هكذا أجبته، لكن الذكريات أخذت تتدفق كحمم ساخنة جالبة معها شيئاً من الغصة والألم.
لم تشبه حياتي أنا وشقيقاتي، في ذلك العمر، أياً من أقراننا، فقد نشأت في بيت بصبغة سلفية، حيث نحيا في سجن من المحرمات التي كان أكثرها مباحاً للعائلة والجيران والزملاء، والتلفاز في منزلنا أشبه بقطعة ديكور، فهو مغلق معظم الوقت، ويحظر علينا مشاهدة شيء غير برنامج الأطفال الصباحي "عالم الكرتون" و"سينما الأطفال" في صباح يوم الجمعة، والاستماع إلى القرآن الكريم وخطبة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وفي المساء كان أبي يشاهد نشرة أخبار التاسعة قبل أن نخلد إلى النوم.
في بيتنا كانت الموسيقى والأغاني والأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات من المحظورات، وأحياناً كان والدي يشاهد مباريات كرة القدم، فكانت أمي تستاء وتقول إنها حرام، وأن اللاعبين لا يرتدون ملابس شرعية، هكذا قال لها مشايخ الدعوة السلفية الذين كان والداي، كعشرات الآلاف غيرهم في التسعينيات، يحضران دروسهم وخطبهم في المساجد، ويشترون شرائطهم التسجيلية ومؤلفاتهم وكتبهم طمعاً في القرب من الله.
وكان منزلنا يعج بشرائط الخطب الدينية لمشايخ السلفية، مثل محمد حسان ووجدي غنيم ومحمود المصري وكثيرين لا أعرف أسماءهم، وبالكتب الدينية، كمؤلفات بن باز وابن عثيمين والدكتور عمر عبد الكافي.
جسد من زجاج
أشعر أحياناً بأن أبي وأمي ظنا أني لم أكن طفلة من لحم ودم، بل من زجاج سيتهشم أو ثلج سيذوب ويتلاشى إن سمحا لي باستكشاف العالم من حولي، لم يكن مسموحاً لي بزيارة أي زميلة دراسة أو اللعب مع أطفال الجيران، وأعاني الأمرين لأقنع أمي بالسماح لي بالذهاب في رحلة مدرسية بسبب خوفها علي، ناهيك عن قائمة من المأكولات والمشروبات المحظورة أو شبه المحظورة لأسباب صحية خوفاً على سلامتنا، تتضمن رقائق البطاطس والمياه الغازية والوجبات السريعة الجاهزة، ومع ذلك كنت هزيلة ومريضة معظم الوقت.
لم تشبه حياتي أنا وشقيقاتي، في ذلك العمر، أياً من أقراننا، فقد نشأت في بيت بصبغة سلفية، حيث نحيا في سجن من المحرمات التي كان أكثرها مباحاً للعائلة والجيران والزملاء، والتلفاز في منزلنا أشبه بقطعة ديكور... مجاز في رصيف22
ولأننا كنا دائمي التنقل، من بيت إلى آخر ومن مدرسة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة، أخذت عزلتي تتعاظم، فلم يكن لي أصدقاء على الإطلاق، صادقت وحدتي والقصص والروايات التي كنت أستعيرها يومياً من مكتبة المدرسة، وألتهمها بشراهة في طريق العودة إلى البيت وقبل تناولي للغداء والبدء في مذاكرة دروسي، وأعود في اليوم التالي متلهفة لاستعارة كتاب آخر، وخلال الإجازة الصيفية أخربش على الورق محاولة كتابة رواية أو قصة قصيرة.
لحسن الحظ، اقتنينا جهاز كمبيوتر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، به عدد من الألعاب المسلية ورسوم متحركة مدبلجة، بعضها اكتسى بصبغة سلفية والبعض جرى تحريفه على نحو مضحك ليخدم أفكاراً دينية بعينها، وغالباً ما كانت تتضمن تيمات الحرب والجهاد والشهادة والفتوحات الإسلامية، بجانب عدد من الأناشيد الإسلامية دون موسيقى وإيقاع.
الدخول إلى صندوق الدنيا
حين انتقلنا من منزلنا إلى بيت العائلة في الإسكندرية، بدأت الحياة تتخذ نهجاً أكثر متعة، إذ أصبح بمقدوري قضاء وقت أطول مع جدتي وخالي، لاسيما خلال الإجازة الصيفية، فقد كان الصعود إلى الأعلى يومياً بالنسبة إليّ كالدخول إلى صندوق الدنيا والاطلاع على العالم الخارجي.
على النقيض من منزل أبوي، كان التلفاز لا ينطفئ في شقتي جدتي وخالي إلا عند النوم، ويمكنني الإمساك بالريموت كنترول للتحكم في القنوات الفضائية بحرية تامة، بينما في بيتنا كان الدش وجهاز الريسيفر ينظر إليهما وكأنهما رجس من عمل الشيطان، والقنوات الفضائية بها فسق وفجور يجب ألا تطلع عليها الفتيات الصغيرات أمثالنا.
أذكر أن جدتي كانت تتابع المسلسل التلفزيوني الشهير "الحقيقة والسراب"، ووجدت نفسي مجذوبة إلى عالمه الذي أراه للمرة الأولى في حياتي، فأصبحت أصعد كل يوم إليها في نفس موعد إذاعة المسلسل، لأتابع معها حلقاته خلسة، دون علم أبوي.
يوم حصلت على موافقتهما لأقضي الليلة مع جدتي وأعود إلى شقتنا في الصباح، كدت أطير فرحاً، بينما قضينا الوقت في مشاهدة التلفزيون حتى وقت متأخر من الليل، كان فيلم "دعاء الكروان" المأخوذ عن رواية عميد الأدب العربي طه حسين، معروضاً على إحدى القنوات.
سحرني عالم أمنة وهنادي، تعاطفت معهما وتألمت لأجلهما، داهم جدتي النعاس فأخلدت إلى النوم، أما أنا فقضيت ليلتي أشاهد الفيلم حتى المشهد الأخير الذي حل عند الفجر، وتركني بعقل مشغول بالتساؤلات وروح تحلق منتشية، منذ ذلك اليوم عشقت عالم السينما وأدركت أن هناك حياة أجمل خلف جدران المنزل.
السير على الشوك والرقص مع النار
كنت في الحادية عشر حين باغتني البلوغ، قبل أن أدرك ماهيته، فقد كنت لا أزال محض طفلة نحيلة، تكاد تخلو من أي معالم أنثوية، نبت لها شاربان وتناثرت الشعيرات السوداء على بشرة وجهها وساعديها البيضاء، عقلها لا يزال متعلقاً بالدمي والألعاب والرسوم المتحركة والسباحة في ماء البحر.
أخبرتني أمي أنني الآن صرت أحاسب على كل ما أفعله، وأنه يجب علي ألا أخرج من البيت مجدداً دون ارتداء الحجاب، ووجدت نفسي أرتدي خماراً أزرق اللون يكاد يلامس الأرض، وجونلات أطول من ساقي، أتعثر فيها ويتكرر انزلاقي وسقوطي أرضاً، لم يكن مسموحاً لي بارتداء بنطال، فكان هذا أول مطالبي المشروعة في طريق مفروش بالشوك.
أتساءل أحياناً لماذا لا أحب أن يتم التقاط الصور لي؟ نادراً ما أجد لي صوراً التقطت بمحض إرادتي ولم تكن جزءاً من مناسبة عائلية، أو فعالية ثقافية، أو شيئاً يخص العمل أو الأوراق الرسمية، تذكرت أن كراهيتي لصوري بدأت في ذلك الوقت الذي حرمت فيه من طفولتي وتحولت إلى هيئة سيدة خمسينية على الأقل، فقدت ثقتي بنفسي وصرت أتجنب الظهور في الصور العائلية، حتى أنني اقتصصت الأجزاء التي أظهر فيها وانتزعتها من الصور، كنت شديدة الخجل من هيئتي التي أجبرت عليها، أردت أن أختفي ويختفي أثر تلك الفترة من حياتي، لكني لم أستسلم.
أزعم أنني لم أحصل على شيء بسهولة، إنه أمر شديد الندرة في حياتي، لست محظوظة لأربح الجوائز واليانصيب أو أجد الكنوز، لم تمطر السماء فوق رأسي ذهباً، بل كانت حياتي أشبه بتسلق قمم الجبال، فقط كنت أعرف دوماً ما أريد وأسعى لتحقيق أهدافي وأحلامي حتى لو كلفني ذلك السير على الشوك والرقص مع النار.
أشعر أحياناً بأن أبوي ظنّا أني لم أكن طفلة من لحم ودم، بل من زجاج سيتهشم أو ثلج سيذوب ويتلاشى إن سمحا لي باستكشاف العالم من حولي... مجاز في رصيف22
لا يهم كم لاقيت من تعنيف وعقاب جراء رغبتي في التحرر من سجن المحظورات، لكني نزعت الخمار الطويل وارتديت طرحة عادية، أردت أن أرتدي بنطالاً وثياباً عصرية. لا ضير عندي من كونها محتشمة ما دامت لا تجعل مني أضحوكة بين الناس، أن أضع طلاء الأظافر وأقصد صالون التجميل لنزع الشعر الزائد من وجهي، وهو ما تحقق لي حين التحقت بالمدرسة الثانوية، وحصلت على هاتف محمول، غير أني كنت لا أزال، وشقيقتي الأصغر مني، نسترق الاستماع إلى الأغاني مع زميلاتنا، وننتهز فرصة خروج والدينا من البيت لنشاهد فيلماً أو فيديو كليب، بينما نخفض الصوت إلى أقصى حد ممكن، ونلتصق بالتلفزيون لنستمع إليه خشية أن يعود أبوانا ويتم ضبطنا بالجرم المشهود.
بوكيمون أنا يهودي!
في عمر مبكر دقت نواقيس الخطر بداخلي، فبينما كنت في الثامنة، كان رجال ذوي لحى طويلة وجلابيب بيضاء يقفون أمام باب مدرستنا، يوزعون علينا منشورات كتب عليها تحذير من مسلسل الكرتون الياباني بوكيمون، بزعم أنه إسرائيلي وأن معناه أنا يهودي، وأسماء البوكيمونات ألفاظ شركية وسب للذات الإلهية، وأخرى تزعم أن معنى "كوكاكولا" لا مكة لا محمد، وغيرها من الهراء الذي روّج له أنصار الدعوة السلفية في مصر خلال التسعينيات، أذكر أنهم نشروا شائعة بأن سلسلة سوبرماركت شهيرة هي إسرائيلية، إبان الانتفاضة الفلسطينية ومقتل محمد الدرة، فخرجت تظاهرات لأطفال المدارس اقتحمت تلك المحلات ورشقتها بالحجارة، حتى أغلقت جميع الفروع.
حين كنت في الثامنة أخبرني قلبي أن أخفي عن أمي أن لي صديقة دراسة مسيحية الديانة، اضطررت للكذب خوفاً من أن تجبرني على الابتعاد عن سارة، الفتاة الأكثر لطفاً بالنسبة لي في الصف، لكني أجبرت على ذلك على أي حال، بعدما نقلني أبي من مدرسة لأخرى للمرة الثانية، فقد التحقت بخمس مدارس مختلفة وغالباً ما كنت أعجز عن الاحتفاظ بصديقة.
عالم الفتيات قاس لا يرحم
بينما كنت في المرحلة الإعدادية كانت رفيقة مقعد دراستي نصف روسية ونصف مصرية، عادت لتوها مع عائلتها من موسكو، وتتحدث العربية بلكنة غريبة لكنها محببة أيضاً، رأيت في عينيها لمعاناً ساحر يختلف عن عيوننا المعتمة، وكأن وهج الحرية بداخلها لم ينطفئ بعد، أذكر أن مشاعر زميلاتي تجاهها كانت تتراوح بين الانبهار والحسد والازدراء، حولها تلتف الفتيات ويبدين إعجابهن ويمطرنها بالأسئلة عن بلاد الروس، لكن من خلف ظهرها يخبرنني بأنها تأكل ساندويتش المارتديلا المصنوعة من لحم الخنزير، وأن أمها الروسية كافرة وترتدي البيكيني، ويتحدثن سراً عن علاقاتها الجنسية مع صديقها الحميم الذي لم أره يوماً ولم تحدثني عنه وأنا التي تجلس جوارها طوال العام.
أعتقد أن خيال المراهقات جعلهن ينسجن الحكايات حولها، بدافع الغيرة؛ فعالم الفتيات قاس لا يرحم المختلفات إن كن أكثر تحرراً أو أكثر تشدداً في مظهرهن وسلوكهن، ينبذن الدميمات وقديمات الطراز ويحقدن على الجميلات ويتملقونهن في الوقت نفسه.
كانت مرحلة الثانوية الأفضل بين سنوات المدرسة، إذ كنت محظوظة لأكون جزءاً من شلة البنات الروشة، الأجمل والأكثر عصرية في صفي والصفوف المجاورة، كنت قد بدأت العناية بمظهري، أرتدي ثياباً على الموضة وأقصد صالون التجميل.
أما زميلاتي غير المحظوظات، ممن فشلت معارك نضالهن ضد أسرهن المتشددة، فكن يحاولن النجاة في مجتمع الفتيات، إما بنسج الأكاذيب عن مغامراتهن العاطفية الساخنة التي هي من وحي خيالهن، كما فعلت كل من دينا وندى، وأما بطريقة بروين وأمل، فقد كانت لهن طرق أكثر قسوة للانتقام من أسرهن، بخلع الحجاب بعد مغادرة البيت، الهروب من المدرسة وإقامة الكثير من العلاقات مع الشباب. قليلات هن من لم يخرجن عن تعاليم الأهل المقدسة واحتفظن بعزلتهن وسذاجتهن الطفولية.
لو لم تنبت لي أجنحة من قراءة الكتب
بعد نجاحي في الثانوية العامة بمجموع كبير والتحاقي بكلية الإعلام، بدأت أسرتي في التغير، وللمرة الأولى حصلت على قدر جيد من الحرية، عقب ستة عشر عاماً من القيود، فسمح لي بوضع مساحيق التجميل وارتداء العدسات اللاصقة الملونة، وأدخل لنا والدي للمرة الأولى طبق الدِش وجهاز الريسيفر وشبكة الإنترنت.
وصار مسموحاً لنا مشاهدة المسلسلات التركية والأفلام الأجنبية، وحين تأتي مشاهد القُبلات تضغط أمي على زر الريموت لتغيير القناة، كان المسلسل التركي "نور" أول مسلسل تجتمع أسرتي لمشاهدته للمرة الأولى في حياتنا، حتى إن والدي صار يشتري لي العطور والمكياج كلما سافر خارج البلاد، واصطحبتنا أمي للسينما عدة مرات، وأخذتنا في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ التي اعتبرها المشايخ سابقاً قطعة من جهنم.
نعم نجحت في التحليق، بعد كل هذا أتساءل ماذا لو لم تنبت لي أجنحة من قراءة الكتب ولم تجذبني نداهة الدراما؟ هل كنت سأبقى وأخواتي رهائن سجن المحظورات؟ وهل لتغير أسرتي علاقة بنضالي لانتزاع حقوقي الطبيعية؟ ماذا عن شباب أمي الذي أضاعه شيوخ السلفية بفتاوي ظلامية حرمتها من حقها في العمل والحياة؟ وماذا عن مصائر زميلات دراستي الذين عانين النشأة نفسها؟ أتراهن تحررن من سجنهن أم ابتلعهن ظلام التشدد في جوفه؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


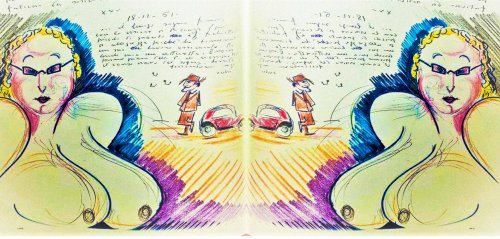



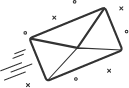
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 17 ساعةجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ يومينمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ يومينفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ يوميناهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار