أفكر في شارلي شابلن، وأنا أتابع صديقي النجار وهو يتحدث إلى آلته: "الله! طب ليه كدا؟". ثم يربت على الماكينة، ويضيف بلهجة اعتذار: "معلش... خلاص". رغماً عني، أدحرج ضحكة، وأتساءل: "إنت بتكلم الصينية يا أسطى؟". يهز رأسه، بما يعني أجل. ويوضح لي أن تلك الماكينة صديقته ومعشوقته، وكثيراً ما يلاغيها أثناء العمل. ليست هذه الماكينة فحسب، بل معداته كلها التي يتعامل معها كما لو كانت من أفراد أسرته. فهو يحزن على كسر الشاكوش، كما يحزن على ابنه إن أصابه مكروه. تلك العلاقة ذكرتني بشخصية سبعاوي؛ فؤاد المهندس، في فيلم "عائلة زيزي". ذلك المهندس الذي يعشق الماكينات، فتدور حياته في فلكها. تلك العلاقة لا بد وأنها كانت ستصيب شارلي شابلن بخيبة أمل عظيمة. إذ كان يؤمن بأن الآلات الحديثة ستشكل خطراً حقيقياً على البشرية، وأنها لن تعمل على خدمة الإنسان، بل على استعباده، وهو ما عبر عنه من خلاله فيلمه "الأزمنة الحديثة"، الذي عُرض عام 1936. فأحداث الفيلم تدور داخل مصنع ضخم يكتظ بالماكينات التي تستغل البطل لخدمتها، ولتسخيره لها. الفيلم بمثابة رسالة تحذيرية للعالم، من الوحوش المعدنية القادمة. هذا الهاجس لم ينتَب شارلي الفنان فحسب. آينشتاين، العالم، كان أيضاً قد أعلن عن امتعاضه من كثرة الأجهزة الجديدة، مؤكداً أنها ستكون السبب الرئيس والمباشر في البطالة، إذ ستحل الماكينة محل الإنسان في الأعمال كافة. لكن، ما الذي يدفع فناناً، وعالماً، إلى الخوف من التقدم التكنولوجي؟
أصبح الاختراع هو الحاجة كلها، يحيط بنا في كل مكان، ويشاركنا العمل، والبيت، وأوقات الراحة، وربما النوم. لذلك، فمن الطبيعي جداً أن تتكون عاطفة ما مع تلك الآلات
شابلن مثلاً، وعلى الرغم من كونه فناناً عبقرياً متفرداً، إلا أن في داخله جانباً أصولياً، يتمسك بالقديم، ويخشى من القادم. وقد يبدو ذلك واضحاً حين رفض السينما الناطقة، وناهضها، وأصر على أن يستمر في تقديم أفلامه الصامتة، على الرغم من التفاف العالم حولها. والسؤال هنا: أليست السينما صناعة تعتمد على المعدات والتقنيات المبتكرة؟ ماذا لو أن شابلن لم يلتحق بتلك الصناعة، هل كنا سنعرف عن فنه شيئاً؟ أم كان سيظل فنان شوارع، أو فنان سيرك؟ ثم كيف يكون شارلي الممثل/ المخرج/ المنتج/ المؤلف الموسيقي/ صانع المونتاج، من دون أدواته، وكاميراته؟ وما علاقته بأدواته؟ والأهم: هل استعبدت الآلات الإنسان كما ظن شارلي؟ هل أدت إلى البطالة كما توقع آينشتاين؟
الآن، وبعد مرور قرن على مخاوفهما، يمكن أن نستشف الإجابة من خلال حياتنا اليومية. لقد أصبحنا المستقبل الذي كان بعيداً، نحن جيل ما بعد الألفية. الألفية، أو الهوس الذي أشعل مخيلة الأدباء والعلماء في العصور البعيدة والقريبة، صارت عصرنا. وفي عصرنا هذا قد نلاحظ أموراً عدة، منها تحرير الإنسان من أعمال استعبادية. ففي الأفلام القديمة على سبيل المثال، كثيراً ما كنا نرى السيد وهو يجلس على عرشه المهيب، بينما يحمل اثنان من العبيد ريشة ضخمة يحركان بها الهواء، أو نرى السيد نفسه يتحرك بموكبه الذي يحمله أربعة من الرجال الأشداء. انقرضت تلك المهن لتحل محلها الماكينات الجديدة، كالمكيّف، والسيارات الحديثة، وغيرها...
هناك أعمال أخرى تعتمد على القوة والمشقة، كالحفر، ونقل الصخور. ربما شاهد الكثيرون منا اللوحات التي وثقت حفر قناة السويس، ومعاناة العمال، وموت العديد منهم تحت ضغط العمل والمرض. ونتابع اليوم المشروعات الضخمة، كبناء، أو حفر، أو تأسيس طرق جديدة، أو حتى حفر قناة سويس أخرى، وكيف يسير العمل بانتظام ودقة من خلال الآلات العملاقة.
بعض الأعمال تحتاج إلى دقة كبيرة، لا يمكن أن تتوافر للإنسان. والنماذج على ذلك لا يمكن حصرها. ولعل أبرزها عمليات الليزر في شبكة العين مثلاً. كيف يمكن للإنسان أن يقوم بذلك من دون التكنولوجيا الحديثة؟
إذاً، فالآلات لم تستعبد البشر، إنما البشر هم من يستعبدون غيرهم. أما البطالة، فأعتقد أن نظرة آينشتاين إليها، لم تكن شاملة. أجل، قد تقوم الآلة الواحدة بعمل يحتاج إلى مئة عامل. لكن كم عاملاً شارك في صناعة الآلة نفسها؟ كل أداة، أو ماكينة نستخدمها اليوم، تقف خلفها مصانع، وعمال بلا حصر. لقد أصبح توقف الآلات دلالة حديثة على توقف العمل، وانتشار البطالة، وتعطل عجلة الإنتاج.
ما يصيبني بالهلع الحقيقي، هو فقدان التكنولوجيا الحديثة؛ أن أستيقظ من نومي ذات صباح ولا أجد للتكنولوجيا أثراً
لم يعد الاختراع من أجل الحاجة، بل أصبح الاختراع هو الحاجة كلها، يحيط بنا في كل مكان، ويشاركنا العمل، والبيت، وأوقات الراحة، وربما النوم. لذلك، فمن الطبيعي جداً أن تتكون عاطفة ما مع تلك الآلات. ولعل ذلك يعود إلى المعاشرة، فصديقي النجار يقضي معظم وقته مع ماكيناته، ومعداته، ويتعامل معها طوال النهار. ومن الطبيعي أن تنشأ بينهما صداقة من نوع خاص. كذلك الأمر بالنسبة إلى صديقي الذي يعشق سيارته، ويدللها، ويجلب لها الهدايا، ويغالي في الخوف عليها، الأمر الذي دفع زوجته إلى الغيرة منها، إذ كثيراً ما كانت تردد عليه وقت المشاحنات: "يا عم عاملني زي ما بتعامل عربيتك". يوضح لي صديقي أن سيارته جزء منه، إلى درجة أنه عندما يداهمه مطب، وما أكثر المطبات في بلدنا، أسمعه يهتف متألماً فعلاً: "آه". أما أخي الأصغر، فيفضل جهاز "البلاي ستيشن" على الأصدقاء، ويؤكد لي أن داخل تلك الألعاب شخصيات مبتكرة ارتبط بها، وأحبها، وفضلها على أصدقائه، موضحاً أن الساعات التي يقضيها في فك ألغاز الألعاب، أو في محاولات عبور المراحل المختلفة، أمتع له بكثير من الجلوس في المقهى، وتبادل النميمة مع الأصدقاء، وتدخين الشيشة.
إذا كان أخي استبدل الصداقة بـ"البلاي ستيشن"، فإن البعض استبدلوا الزوجات بالدمى الجنسية، أو استبدلن الأزواج بالألعاب الجنسية. تلك نقلة جديدة في عالم التكنولوجيا. لقد أصبحنا نضاجع الآلات والماكينات الحديثة.
تلك التكنولوجيا هي التي جعلتنا نحيا حياة لم يعشها أعظم أباطرة العالم قديماً. نحن نسافر اليوم بالطائرة، وبضغطة على زر الريموت، نختار درجة الحرارة، والرطوبة اللتين نرغب فيهما، ونتواصل مع أشخاص بيننا وبينهم آلاف الأميال، ونشاهد العالم كله "أون لاين". في رأيي، لم تكن مخاوف شارل شابلن في محلها على الإطلاق. إنه الخوف من المجهول، هو الخوف نفسه الذي يعاني منه البعض الآن، إذ تعبّر السينما العالمية والمحلية عن خوفها من الإنسان الآلي. وهو أمر عجيب، فبالأمس كنا نتحدث عن علاقة الإنسان بالآلة، واليوم نتحدث عن الإنسان الآلي. وهذه مخاوف لا تشغلني في الحقيقة. ما يشغلني فعلاً، وما يصيبني بالهلع الحقيقي، هو فقدان التكنولوجيا الحديثة؛ أن أستيقظ من نومي ذات صباح ولا أجد للتكنولوجيا أثراً، أي تكنولوجيا. هل يمكنك أن تتخيل الحياة من دون أي آلة؟رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


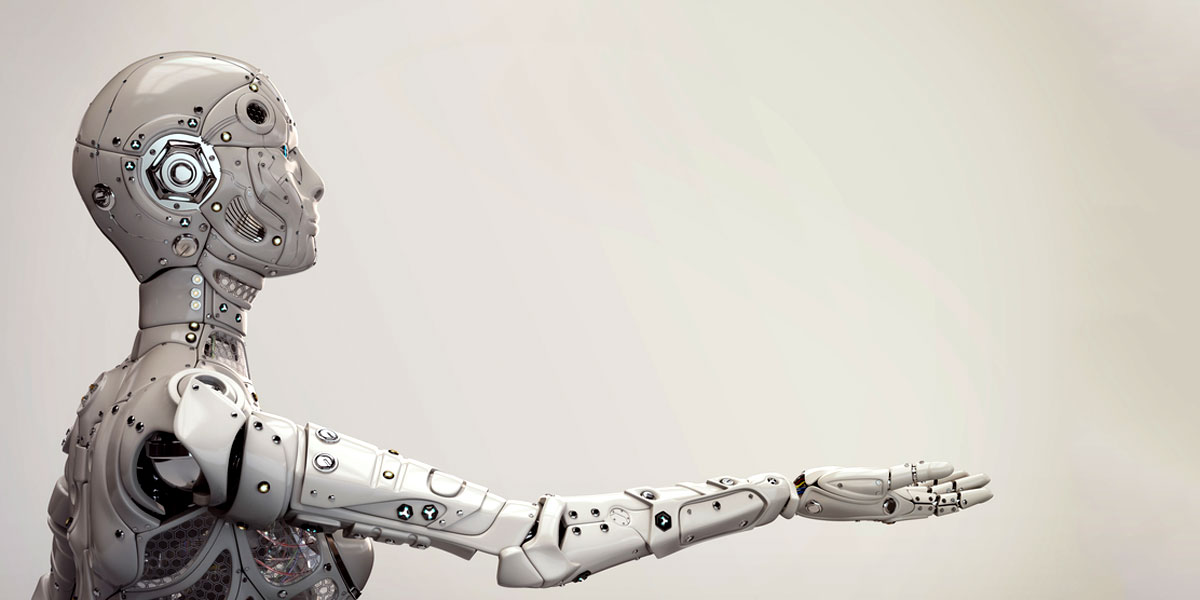
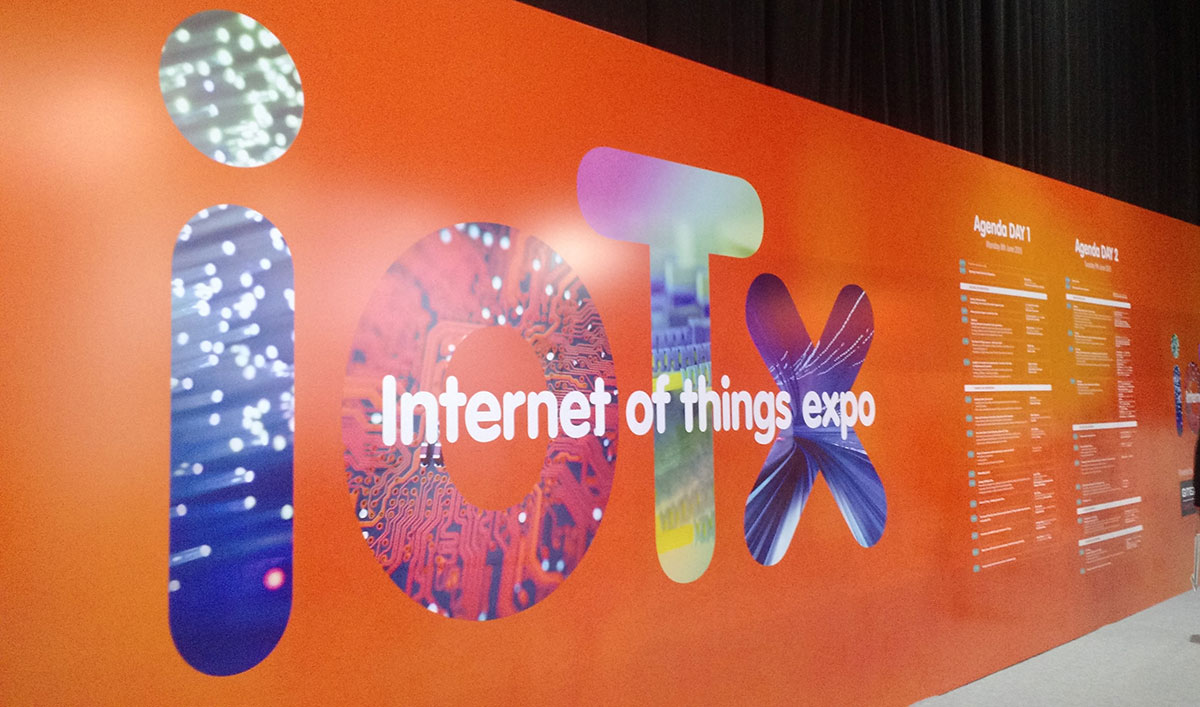


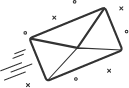
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومينUn message privé pour l'écrivain svp débloquer moi sur Facebook
مستخدم مجهول -
منذ يومينالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ يومينأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ 3 أيام❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 5 أيامجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ أسبوعمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.