لا يوجد فترة زمنية محددة لظهور أعراض النوستالجيا أو "ألم الحنين إلى البيت"، فقد تبدأ بالتجلّي بعد عام أو عشرة، وأحياناً، بعد عدة إيام من مغادرة "المنزل". هذا الزمن ومقداره وامتداده لا يشير له ميلان كونديرا حين يتحدث عن ألم العودة أو الرغبة بالعودة، خصوصاً أن الماضي و"منزله" يحويان عاملين مهمّين، جغرافي وزماني، وكلاهما يتضمنان أماكن وكتباً وأشخاصاً وذكريات، تتداعى حين نكون أبعد دون أن نعلم بدقّة متى بدأت بالظهور.
حالياً، ومع عودة الحياة نوعاً ما إلى "شكلها الطبيعي"، يمكن القول إن هناك ألماً بدأ يظهر عند هؤلاء الذين "عادوا" إلى الخارج، حيث الزمن التقليديّ والآخرون والاستعراض، ألم يشبه أول نوبة الفزع، ما يلبث أن يتلاشى ثم يعود بعد ساعة أو أكثر، أشبه بوخز أسفل البطن لا نعلم بدقة سببه.
ونشير إلى أننا نستخدم كلمة عودة بسبب تكرارها حين الحديث عن الشكل الطبيعي، فـ"العودة إلى الخارج"، لا إلى المنزل، وكأن الخارج هو الأصل، والداخل مجرّد مكان مؤقت نعبره و"نرتاح" فيه من أجل الخروج.
يرافق الألم أو الوخز السابق رغبة بالرجوع إلى "المنزل" بمعناه الحرفي، المكان الذي قضى البعض منا فيه سنة ونيّف، محجورين ومختبئين في جزرهم الخاصة وكنباتهم وشاشاتهم، بعيداً عن "الآخرين"، مُصغين إلى أصواتهم الخاصة، ينعمون في صمم مُصطنع يحميهم من ضجيج المدن وتسارع إيقاعها.
تلك المدن التي تريد الآن استعادة وطأتها، تصفع الخارجين وتعيد لهم السمع، وكأن غابات الإسمنت ازدادت قساوة فجأة، وتحاول إعادة فرض نفوذها وإيقاعها على اللحم الطريّ الذي اعتاد راحة الأريكة.
لكن ما الذي نحنّ إليه في منازلنا، نحن اللذين تأففنا وهُددت كياناتنا بسبب الحجر الصحي، واغتمنا كل فرصة للتسلّل إلى "الخارج" وإعادة اختباره؟
حقيقة، لا يمكن أن نعلم، لأن النوستالجيا نفسها تحوي ما هو مجهول، وما لا يمكن تحديده، هناك "شيء ما" نحنُّ إليه دون أن نعرفه، نعم هو فضاء المنزل الخاص بكل إمكانياته لكن هناك شيء آخر، لأننا، بصورة ما، لم نكن فقط معزولين عن بعضنا البعض، بل مختبئين، كل في "مأوى"، في مكان يعلم ألا أحد سيراه فيه أو يجده.
لا إتقان في المخبأ
يشير جورجيو أغامبين في كتاب له بعنون "تدنيس" إلى العلاقة بين الطفولة والاختباء، ويقول إن الأطفال يجدون متعة في التلاشي عن أعين الآخرين، "لا لأن أحد سيجدهم في النهاية، بل بسبب فعل الاختباء نفسه، فأن يكون الواحد منهم متخفياً في سلة ثياب أو خزانة أو زاوية العليّة، يعني اختباء حد الاختفاء".
حالياً، ومع عودة الحياة نوعاً ما إلى "شكلها الطبيعي"، يمكن القول إن هناك ألماً بدأ يظهر عند هؤلاء الذين "عادوا" إلى الخارج، حيث الزمن التقليديّ والآخرون والاستعراض
متعة اللعب هذه تتمحور حول الاختباء أو التخفّي، وتزداد إن كان هناك مكان للمراقبة، أي اختفاء يتيح لنا أن نحدق دون أن يُحدّق بنا، ولو للحظات، بعيداً عن أعين من يمكن أن يجدنا.
هذه المراقبة تفعلها فتحات من نوع ما، نوافذ، شاشات، شقوق في الجدران، مساحات نُطلّ فيها على الخارج دون أن نختبره كليّاً، نلتقط لطائفه كمن يصنع كولاجات متغيرة لصور مختلفة دون أي ترتيب، مشابهة لتلك التي جمعها هاوي التصوير أناتول فازنبيان، الذي أخبرنا عنه ألبرتو مانغويل في روايته "عاشق مولع بالتفاصيل".
أناتول فازنبيان الذي يختبئ خلف باب خشبي في الحمام العمومي، ويلتقط لا ما تراه عينه، بل ما تراه عين كاميرته، يُكدّس ويجمع من مخبئه "صوراً" لمتعته الشخصية، تلك التي تختصر بكونه مختفياً و قادراً على "اقتناص" تفاصيل الخارج: قدم، يد أو ربما سُرّة.
هذا الكولاج لا ينتمي فقط إلى المخيلة وعالم الرواية، في عالمنا هذا المحكوم بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. "صور المحادثات-screen shots" تنتشر بصورة يوميّة و يتم تبادلها إما علناً أو سرّاً، ترافقها حكايات لبضعة ثوان تتكرّر أمامنا على الشاشة، منها الفضائحي ومنها الحميمي وبعضها يلتقط الحياة اليوميّة ويؤطّرها، تفاصيل مختلفة تتفاوت جدّيتها تصلنا جاهزة إلى الشاشة، وتترك لنا حرية تأويلها في الكثير من الأحيان.
ازدادت جديّة هذه الظاهرة حين حاولت بعض شركات الهواتف النقالة أن تشير إلى المتحدثين/ المدردشين وتنبههم إلى أن واحداً منهم التقط screenshot، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين، كونه يفعّل الشعور الدائم بالمراقبة ويهدّد الاتفاق الضمني على السريّة، القائم على الثقة لا الشفافية التكنولوجيّة.
لكن ما الذي نحنّ إليه في منازلنا، نحن اللذين تأففنا وهُددت كياناتنا بسبب الحجر الصحي، واغتمنا كل فرصة للتسلّل إلى "الخارج" وإعادة اختباره؟
لا موهبة في التلصص من المُعتزل أو المخبأ، مُجرد تحديقة تقودها الغريزة نحو موضوع الرغبة الخارجي، وهذا ما نتلمّسه ضمن حركة الكاميرا في "فيلم قصير عن الحبّ" لكريستوف كيشلوفسكي، إذ نشاهد بعين المتلصص المختفي كيف يتلصص على موضوع رغبته، وأحياناً يتجرأ على الخروج من مخبئه، مُصمّماً على ألا يميزه أحد، ذات المتلصص هذا "يتألّم" إن تم التعرّف عليه أو الاعتراف بوجوده، لنراه فجأة يركض إلى مخبئه مسرعاً، ليتلقط أنفاسه في مساحة أمانه الكليّ.
وخز البطن كمقياس للعالم
تكثر المقالات والنصوص حالياً عن الخوف من العودة إلى الخارج، خصوصاً أن الآخرين الآن يبدون في الخارج وكأنهم وُلدوا من جديد. يعيدون النظر في مهارات وآداب الاجتماع، إذ نراها إما مُبالغاً بها أو شحيحة بسبب عام ونيف من التباعد الاجتماعي، والأهم بعد اكتشافنا إمكانيّة اختزال الكثير من متطلبات "الخارج"، وخصوصاً تلك المتعلقة بالعمل وضروراته والتفاهات الكثيرة المرتبطة به.
لكن ما سبب الألم؟ وذاك الانقباض في أسفل البطن حين نكون خارجاً؟ الأهم كيف نتحدّث عن ألم في الخارج ونحن واعون لوجوده، أي نحن أمام ألم لا يهدّد الوعي أو الإدراك، وجع لم يتركز في مكان واحد حدّ نفي اللغة.
لرصد هذا الألم نعود لتعريف النوستالجيا التي ترتبط بالمكان الجديد "أي الخارج في حالتنا"، فحين نتتبع منشأ الكلمة نرى أن هذا المكان الجديد يحوي الجهد والعمل، إذ أُطلقت الكلمة لوصف حنين الجنود إلى أوطانهم، وحنين العبيد إلى قراهم، وحنين المهجّرين إلى بيوتهم، أي هناك رغبة بالعودة إلى زمن الراحة، حيث الزمن أبطأ وأقل صرامة وقياسيّة من الخارج الذي يتطلب مواعيد واستعراضاً أمام الآخرين.
زمن الاختباء أشد طراوة، تحكمه الرغبة والفتحات المتاحة لها، وهنا يمكن فهم الألم في الخارج: هو لحظة اكتشاف كميّة المقاييس والمعايير والضوابط التي يجب أن نخضع لها، وعي مفاجئ بالجهود المتكررة التي تبدو "عاديّة" وجزءاً من "الحياة الطبيعيّة".
بصورة أدقّ، وعي بـ"الأداء العلني" والسيناريو المرتبط به، ذاك الذي لا ننكر أنه يحوي أجزاء ممتعة وتحدّد "الأنا"، لكن هناك أيضاً ما هو مأساوي، إذ لابد من إتقان إيقاعات خارجيّة لأجل النجاة، تلك التي استغنينا عنها في فترة الحجر، كالانتظار في الدور، ضرورة التسليم على الجيران، شراء الحاجيات من المتجر.
زمن الاختباء أشد طراوة، تحكمه الرغبة والفتحات المتاحة لها، وهنا يمكن فهم الألم في الخارج: هو لحظة اكتشاف كميّة المقاييس والمعايير والضوابط التي يجب أن نخضع لها، وعي مفاجئ بالجهود المتكررة التي تبدو "عاديّة" وجزءاً من "الحياة الطبيعيّة"
باختصار، يمكن القول إننا فرادى أكثر راحة واسترخاء وفهماً لأنفسنا، أما جماعة فنحن أشد توتراً وأكثر خوفاً، ولا ثقة لدينا بالآخرين الذين كُسرت العلاقة معهم كلياً بسبب الوباء، فالآخر "عدو" محتمل، ويحوي احتمال العدوى التي قد تكون مميتة.
من جانب آخر، الألم والشعور بالمطاردة وخصوصاً في المدن، سببه الشبهة التي يتحدث عنها محمد دريوس في نصّ له، فالمخبأ هدف للفضوليين الذين يقوم عملهم على تفكيك مُستقرّك وجنّتك، ففي المدن: "إذا حاولت الانعزال قليلاً فقط ستصبح هدفاً للشكوك، وفي أفضل الأحوال ستكون هدفاً للباعة الجوّالين، إعلانات المخازن الكبرى، اتصالات شركات التأمين وحملات التعداد الوطني...".
أي أن أسوارنا التي نظنّها منيعة تثير الغيظ لدى "الآخرين"، فلا يجوز في المدن تعمير جدران تفعّل لاختباء الكليّ، ما يعني الحرمان الدائم من متعة طفوليّة، متعة الاختفاء والتلاشي، تلك التي تمنح الواحد منا ولو للحظات نشوة يشعر أثناءها كأنه لم يكن موجوداً أبداً.
كلمة "عدو" التي ذكرناها سابقاً وإن كانت مبالغة، تحيلنا إلى العلاقة السياسيّة بين "المخبأ" و"الخارج"، وكما في لعبة الأطفال، مَن في المخبأ آمن، لا يراه أحد، خفي، قادر على استغلال المكان للأقصى ومنصاع لرغباته كليّاً، أما مَن في الخارج فديناميكي، ويتبنّى شكلاً وأداء معيّناً هدفه الدفين إيجاد كلّ من اختبأ.
الأهم يحوي الخارج أيضاً، أولئك الذين قد يقتحمون "المُستقرّ" ويكسرون إيقاع العزلة فيه، لنقل ألمهم الشخصي إلى "المخبأ"، ذاك الذي صمّمناه على مدى عام كامل ليكون فردوساً، لا يدخل بابه إلّا من لا حرج ولا تثريب عليه، بصورة أدق، "جنّة مسوّرة" لم تكن تحوي في المتخيل الديني سوى شخصاً واحداً، وفقدت قيمتها حين أصبحا اثنين.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.






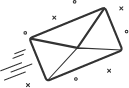
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يومUn message privé pour l'écrivain svp débloquer moi sur Facebook
مستخدم مجهول -
منذ يومالبرتغال تغلق باب الهجرة قريبا جدااا
Jong Lona -
منذ يومينأغلبهم ياخذون سوريا لان العراقيات عندهم عشيرة حتى لو ضربها أو عنقها تقدر تروح على أهلها واهلها...
ghdr brhm -
منذ يومين❤️❤️
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ 4 أيامجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ 6 أياممدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.