كبرت في الغور الحار جدّاً، ولم يكن ثمة مزاح مع هذا الحر. كان ومازال، مثل قرن فلفل من النوع" النحّاس"، نحيل البنية، صلب القوام، سميك القشرة، بِلُب يميل إلى لون السكّر، وعندما أفتحه فإنّ اللهب يتطاير منه، فيحمله الفراغ، الذي يتحول إلى ريح غير مرئية، ويحطه في الجوّ، ليتلقاه فمٌ مغامر أو أنف لا يعرف الحذر.
في القاهرة، عام 2002،في أولى تجاربي التي حدثت متأخراً مع السفر، اختبر جلدي، لأول مرة، الرطوبةَ. كان اختباراً جديداً له، لم يجرّبه من قبل. نَمَت حبيبات صغيرة فوق جلدي وتناثرت، نبتت مثل بذور في أول طلعها، تريد أن تشقّ الأرض وهي تغمض عينيها، كأنها مواليد جديدة مندهشة في لقاء الضوء، أو أطفال في غرفة الأشباح نظراتهم تحط على أذرع الهياكل، تحاشيت حكّ الحبيبات، فمسحت فوقها بيدي رواحاً وعودة، كي لا تهيج، وبدل أن تهدأ نبتت فيها حقول كحقول الفلفل، ثمّ اكتفى الفراغ بفصلها عن امتدادها الشاسع، كجزء من الملكية العامية، كي تكون لي وحدي، وتحكني بدل أن أحكها.
بعد هذا التاريخ من شهر تموز الذي قضيت منه سبعة أيام في الجيزة، أصبح الأمر أنه أينما كان هناك ماءٌ ارتفعت تلك الحقول بتطاولٍ مماثل، وكانت تنطفئ من تلقاء نفسها، دون أن أقطف ثمرها، بمجافاة الهواء المحمّل ببخار الماء، فأغادر وخلفي غابات الضّباب والندى والبلل.
كان الشَعر الخفيف الذي ينبت بينها على ساعديّ، يحاول أن يرفع رأسه، ليحظى بالنظر عالياً من بين درناتها، لكنها كانت تخفيه وتخيفه؛ باطن كفّها على رأسه تضغط، وهي تحاول أن تغرقه في بئر جلدي، وهو كان يحاول أن يشمّ نفَسَه فيخرجُ رأسُ شعرة أو اثنتين من بين سديم الفلفل الموجع، من بين البذور الحمراء. ثمّ سرعان ما تغرق الشعرتان، كأن الكف انتصرت فأغرقت شعرة خفيفة أو شعرتين، فيختفي الحقل الأسود الفاتح برمّته، ويحلّ بدلاً منه حقلُ طيور النحام الوردية.
في مرتيل عام 2009، وفي بارس عام 2013، وفي غزة عامي 2015 و2018، وفي بيروت عام 2017، وفي إليكانتي عام 2019؛ في المدن التي تقع مجاورة للبحار والأنهار، ومنذ وقت قريب، في كلّ فصل من فصول الربيع، في فلسطين، تنبت الأزهار فوق الأرض بشساعتها الرحبة، وينبت فوق جلدي طفح مع تواصل انتشار حبوب اللقاح، فتبدأ الثيران والأبقار والحيايا والكلاب وجراؤها سباقها فوق جلدي.
في الفصول البعيدة، ربيع وراء آخر، كانت هناك أكزيما دائمة في كفّ يدي اليمنى، حتى أن ديمومتها أعطتها معنى كفي، فخلتها كذلك منذ الأزل وإلى الأبد. كانت الأكزيما تجد فرصتها بالزحف مع اشتغالي في قطف الخضار، كانت تتسع وتحفر في باطن كفّي مع قطاف ثمار الكوسا، مع ملامسة ما ينحلب عن سطحه من عصارة لزجة، وعن باطن ثمار الفول بقوامها الخشن، وعن لون ثمار الباذنجان، وكأن اللون يصبح مقابل كفّي مقاتلاً يحمل سيفاً، وكفي ما هي إلا صدر عار دون درع، وكان جلدي المختبئ، على كامل الجسد، تحت الثياب، محتمياً من الحرّ الجاف، خالياً من أكزيما الربيع، كان مازال فصلا للخضرة فقط، وموسما دائما للسمرة النقية تحت الشمس، ومع يدي المتروكة لآلامها كان كأن جلدي كله قد تخلى عن كفي وتركها خلفه، وجلس يحمص نفسه، كبذور عباد الشمس، في مقلاة الشمس، وهي تقاوم وحدها خشونة القطاف، وتجابه آثار المرض.
أول ثوب لبستُه كان جلدي، وكان على ثلاث طبقات؛ البشرة، والأدمة، والأنسجة. وربما من هنا جاءت الفكرة لاحقاً بأنه عليّ أن ألبس أكثر من طبقة من الثياب؛ ثوب، بنطال تحت الثوب، وغطاء على الرأس
أول ثوب لبسته كان جلدي، وكان على ثلاث طبقات؛ البشرة، والأدمة، والأنسجة. وربما من هنا جاءت الفكرة لاحقاً بأنه عليّ أن ألبس أكثر من طبقة من الثياب؛ ثوب، بنطال تحت الثوب، وغطاء على الرأس. كان الاختباء وراء الثياب أكثر من مجرّد حيلة. كان تقليداً، وعادة، وكان أداة حماية، وحولي من النساء اللواتي عملن في الأرض، في تهيئتها لأعمال الفلاحة، وزراعة البذور، وقطف الثمار، فأخفين وجوههن بلفّها بكوفيات، تلثمن متنكرات أو خجولات أمام عيني الشمس. أما أنا فقد تركت وجهي لها، لفمها وأسنانها، صبغتني الشمس، ورشقت على وجهي الكلف، وكانت طبيبة الجلد تقول إنه لا طائل من كلّ ذلك: "لقد خسرتِ مادة الميلانين التي تفرزها الخلايا الطلائية."
كنت أشعر مع هذا التعبير بأن جسدي ما هو إلا غرفة خاوية بأربعة جدران، إذا ما نطقتُ فإن الجدران ستردّ الصوت صدى، وكانت دلائي فارغة من الطلاء، فظلت غرفتي باهتة خالية من اللون، منتحبةً بين الصوت والصدى. الصوت وهو يعيد نفسه، ولا يجيب على نفسه، ولا يجيبه غيره.
كانت هناك امرأة. لكن من هي؟ هل كانت تدر رحمةً على قطعة اللحم التي بين يديها؟ كم مرة بسملت فوق الجلد الذي يغطي اللحم، وماذا تلت عليه، وبماذا دعت له؟
لا أدري، لم تكن درايتي قد تشكلت بعد، لكن ذلك الوقت كان بداية زرعها، فغرست المرأةُ الدرايةَ في جوفي كالرصاص أو الطين أو صرارة تمّ دقّها في قلبي. فوعيت بالإبصار القاسي، عينٌ في القلب أو قلب في العين، ومساماتٌ يقف فيها الشَعر من الدهشة عندما يحدث الوعي أو ينتبه!
مازلت أتذوق ملح السنة الأولى، فوق جلدي، كلّما غسلته، وأنا في عمر الرابعة والأربعين، مثلما مازلت أشمّ رائحة التراب الذي فرمته الجرارات الزراعية التي تجوب الأراضي الشاسعة، وحوّلته من كدر صلبة إلى نثار ناعم، يشبه الدقيق المعجون ببودرة الكاكاو الخشن، ويتناثر في عيني، وتحت ثيابي، لاحقاً، عندما غطى الجلد الأول بطبقاته الثلاث، جلد ثان بطبقات أخرى، بألوان أخرى وبأكثر من ملمس، بعد أن تحولتُ من مجرد مولودة مدفوعة نحو حياتها إلى عاملة في الزراعة تدفع حياة النباتات.
لقد خدعني جلدي، فواصَل تخلّيه عني، وأنا وُجدت فقط لأخدمه. أعمل على حواشيه، فأحرسه، وأمسحه، وأدهنه، وأغطيه، وأعرّيه، وأناضل لأجل أمنياته. فحرّرته في أول معاركي لأجله، من يدي أمي وهي تدعكه في طفولتي بقسوة، كأنها تدعك جداراً
وفوق الطبقات الثلاث، فوق البشرة المدغومة بالملح، والمتبلة بالزيت، من المساء حتى الصباح، بعد الحمام بالماء المنسدح من كوز الماء، في لجن الغسيل، انطلق صوتي، وشقّ البيت الطينيّ. فاستيقظ الفلاحون ذلك الصباح الندي، في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني، بطبقة بيضاء تغطي أوراق مزروعاتهم، وحلّت مكان ذلك، فوق البشرة التي ارتسمت فوقها خطوطٌ رفيعة كالخطوط على سطح بطيخة من نوع كويمسون سويت، بقشرة سميكة تحتمل النقل لمسافات بعيدة، وخطوطٍ فاتحة، ولونٍ لامع. كان جلدي يلمع، وكان الفلاحون يفركون الورق برؤوس أصابعهم، ويحدقون في السماء، ويتساءلون: ماذا هناك؟ ولا يعلمون أنه قد كنت أنا؛ مجرد أنا واحدة لا غير.
غُطِيَ جلدي، مثل جميع المواليد في سبعينات القرن الماضي، بأول ثوب ثان "كوفلية". فتداعت مع الثوب دلالات الفعل "كفل"؛ وُهب جسدي، بعد خروجه من مسبح الخيال، إلى قطعة قماش بيضاء ظلت سترته حتى بلغت العام. وحتى لا أهرب من ثوبي، كما تفعل الطيور، ربط ما كفلت به بالقماط، فأكملت المرأة عملها، فجمعت يديّ ورجليّ، كالأسير، وَوُثقتُ. فقد كنا نحن الأطفال، يخاف الكبار على عيوننا من أيدينا، ومن أيدينا على جلودنا، خشية أن نخدشها بطلع الأظافر. ومن الأيدي والأرض يخاف الكبار علينا من خطواتنا خشية أن تضللنا، فتسول لها الطريق أن تمضي بها، فأمشي قبل أن يأتي موعد بدء السبق في الدروب!
لم أراقب جلدي، على مدى سنوات، وهو يتساقط، مع شعري، على أغلفة الوسائد التي وضعتُ رأسي عليها. ولم أراقب جلدي وهو يتساقط في التاكسيات التي ركبتها، وفي المحطات البعيدة، وفي الشوارع المزدحمة، وعند باعة الخضار، وفي المقاهي، وعلى أطراف البانيو. ظلّ جلدي يتغير بصمت، وبطء، وسريّة، دون أن يلكزني بكتفي كلّما سقطت منه طبقة أو قشرة جافة. ولم يكن ثمة فصل لتغيره، ولا لأنه ثقل حمله على نفسه، كما يثقل حمل جلد الأفعى عليها، فتحكّ جسدها بالصخور والحجارة وأطراف البيوت، فيسقط من أعلى رأسها حتى ذيلها.
لقد خدعني جلدي فواصل تخلّيه عني، وأنا وُجدت فقط لأخدمه. أعمل على حواشيه، فأحرسه، وأمسحه، وأدهنه، وأغطيه، وأعرّيه، وأناضل لأجل أمنياته. فحرّرته في أول معاركي لأجله، من يدي أمي وهي تدعكه في طفولتي بقسوة، كأنها تدعك جداراً. حررته من ملمس الليف الخشن، والأيدي المستعجلة، فأحزرت أول انتصار يحققه المرء لصالح جسده؛ أن يختلي به وحده في مكان مغلق، ويتحسسه. يغدق عليه الماء، ويدعكه، في كلّ مكان.
لم يصبب أحد فوقه الماء، ولم تعد تمرر عليه يد كأنه" لا شيء". جاء يوم جعلت جسدي شيئاً، وصببت الماء بيدي فوق جلدي. دعكته بلطف، ويوماً فيوماً استخدمت له أفضل نوع من أنواع الليف، بدءاً من الليف الطبيعي، وأفضل نوع من أنواع الصابون، بدءاً من صابون زيت الزيتون المصنوع في مصابن مدينة نابلس. ومع اكتشاف قدرة قدميّ على الانتقال، وتحرّر خطواتي ويديّ، سرتُ في الأسواق، فبحثت له عن أنواع الشامبو التي يرضاها، متغاضية عن الثمن واللوم وتأنيب الضمير وترقّب عيون المحيطين.
لكن متى كانت المرة الأولى التي عرفت فيها أنني أرتدي جلدي؟ متى كانت أول مرة حاولت فيها أن أخلعه وفشلت؟ هل قشرته بالسكين، فكنت سمكة؟ متى قررت أن أختبره، فعذبته، فنقطت فوق ركبتي البلاستيك المصهور، وأخطت باطن كفّي، وباطن قدمي، بالإبرة والخيط؟ وهل أحببتُ جلدي، وهل أحبني؟ ومتى كرهته ومتى أحببته؟ وهل اعتدته؟ ومتى أعدت اكتشافه من جديد كأني لم أعرفه من قبل؟
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.


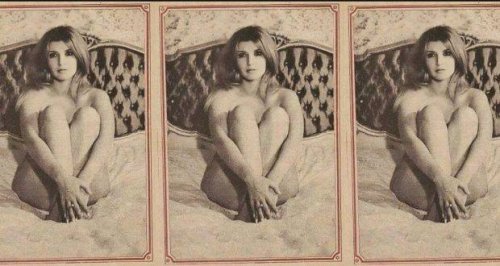



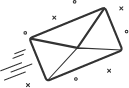
انضم/ي إلى المناقشة
جيسيكا ملو فالنتاين -
منذ يومينجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...
Tayma Shrit -
منذ 3 أياممدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...
مستخدم مجهول -
منذ 3 أياماهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 5 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة
Samah Al Jundi-Pfaff -
منذ 5 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار